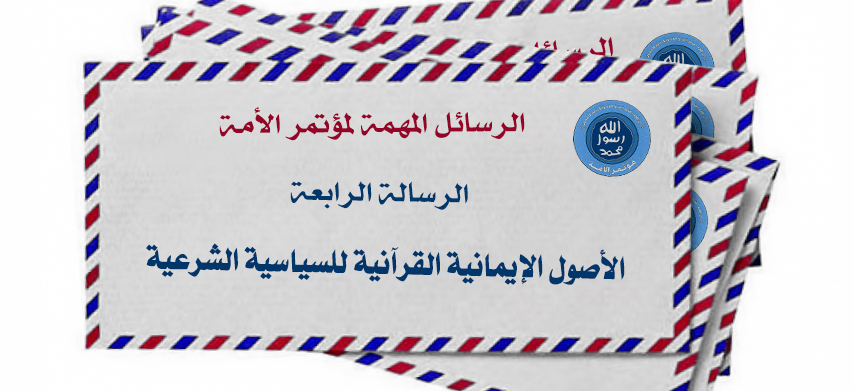
الرسالة الرابعة (الأصول الإيمانية القرآنية للسياسية الشرعية)
- بواسطة مؤتمر الأمة --
- الخميس 15 جمادى الثانية 1434 00:00 --
- 0 تعليقات
الرسالة الرابعة
(الأصول الإيمانية القرآنية للسياسية الشرعية)
أصول الخطاب السياسي القرآني
تعريف أصول الخطاب السياسي:
والمقصود هنا بأصول الخطاب القرآني على وجه الخصوص: الأصول العقائدية الإيمانية، التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة الإسلامية، والتي لا يمكن فهم الأصول العملية السياسية التشريعية، دون فهم هذه الأصول الإيمانية العقائدية، التي دعا إليها الخطاب القرآني المكي، قبل قيام الدولة النبوية في العهد المدني، ومع وضوح هذه الأصول العقائدية في القرآن، إلا أنها لم تعد كذلك في ثقافة المسلمين اليوم، بعد أن طمست معالمها بالتأويل والتحريف المعنوي لدلالتها، من أجل ترسيخ الخطاب المؤول والمبدل الذي يحكم واقع الأمة اليوم، بأنظمته الاستبدادية الفرعونية والقيصرية على اختلاف أشكالها وأنواعها، الملكية، والعسكرية، والجمهورية، هذا الواقع الذي لا يمكن تغييره إلا بالعودة إلى الخطاب القرآني، وفهمه فهما صحيحا؛ ليحدث من التأثير والأثر الخطير، كالذي أحدثه في العالم يوم نزوله، حتى غير مجرى التاريخ الإنساني كله، يوم أن كانت دلالاته ومعانيه، غضة طرية كألفاظه ومبانيه، قبل أن تعدي عليها عوادي التأويل، والجدل والتبديل!
وبالاستقراء والتتبع نجد أن أهم أصول الخطاب القرآني في هذا الباب، قد عالجت الإشكاليات الكبيرة، وأجابت عن الأسئلة الخطيرة، التي طالما حاول الإنسان معرفة الحق فيها، والوصول إلى كنهها، وهي:
ما أصل هذا الوجود؟ وما أصل الإنسان؟ وما طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع الإنساني؟ وما لهم من حقوق؟ وما عليهم من واجبات؟ ومن يحق له تحديد ذلك بينهم؟ وبأي حق يحكمهم؟ وعلى أي أساس يخضعون له ويطيعونه؟ وما الموقف من اختلاف عقائد الناس ومللهم ونحلهم، الذي طالما كان الاختلاف فيها سبب حروبهم وبؤسهم وشقائهم؟ وما الموقف من السلطة التي طالما دار الصراع في المجتمعات حول الوصول إليها، والسيطرة عليها؟ وما الموقف من الثروة والمال؟ ومن يحق له تقسيمهما؟ وكيف يتم توزيعهما؟ وما الحقوق الاجتماعية فيهما؟
إنها القضايا الرئيسة الأربعة (الإنسان ـ الدين ـ السلطة ـ الثروة)، التي طالما دارت الحروب وحدث الصراع في المجتمعات الإنسانية بسببها، وبسبب الموقف منها، وما زال الصراع حولها قائما، فالشيوعية، والرأسمالية، والاشتراكية، والليبرالية، والقومية، والفاشية، والنازية، وكل الفلسفات الوضعية السياسية، ما هي إلا نتاج تلك الأسئلة الخطيرة، والمشكلات الإنسانية الكبيرة، حيث حاولت معالجة قضية الإنسان والسلطة والثروة والدين، ولا يتصور ألا يكون للقرآن هداياته السماوية في هذه القضايا الرئيسة، ولا يتصور أن يكون القرآن كتاب هداية للخلق كافة، وكتاب رحمة وهدى ونور، كما وصفه الله عز وجل ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾([1])، وكما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين﴾([2])، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين﴾([3])، ثم لا يكون له نظام حياة؛ يحقق للإنسانية ما تتطلع إليه من عدل وحرية ومساواة، ويهديها إلى الحق في هذه المشكلات التي تعاني منها البشرية أشد العناء!
وقد تجلت أبرز أصول هدايات الخطاب القرآني في هذا الباب في الأصول التالية:
الأصل الأول: توحيد الله جل جلاله.
الأصل الثاني: توحيد الإنسانية وتكريم البشرية واستخلافهم في الأرض.
الأصل الثالث: تحرير الإنسانية وتجريد العبودية.
الأصل الرابع: دعوة الخلق إلى العدل والحق.
الأصل الخامس: الأخوة الإيمانية والسلطة الشورية.
الأصل الأول: توحيد الله جل جلاله:
وهذا هو أصل الأصول في الخطاب القرآني، وقد جعل شعاره كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، وذلك باعتقاد وحدانيته، سبحانه وتعالى، لا شريك له، في الخلق، والملك، والسيادة، والحكم، والطاعة، والعبادة، كما قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾([4]).
فتوحيد الله وحده لا شريك له في كل ما أوجب إفراده به؛ هو أول واجب على الخلق كافة، كما قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن- وكان فيها يهود ونصارى-: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك - وفي رواية فإن هم أطاعوا لذلك - فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإذا صلوا؛ فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك، فخذ منهم، واتق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).([5])
وهذا الربط الوثيق بين توحيد الله، ودفع الزكاة للفقراء، وتجنب الظلم؛ أوضح دليل على معنى التوحيد ومعرفة مقاصده، إذ دفع الأموال والضرائب لا يكون عادة إلا بعد الإقرار بالطاعة للجهة التي تأمر بدفعها أو جبايتها، وهم الملوك والرؤساء عادة، فكان أول واجب يدعوهم إليه هو توحيد الله وإفراده بالطاعة -التي هي أبرز مظاهر العبودية- له وحده لا شريك له، فلا طاعة للأحبار ولا للرهبان ولا للملوك الذين صاروا أربابا من دون الله، يتحكمون في عباده ويخضعونهم لطاعتهم، ويجبون أموالهم؛ ليزداد الملوك والملأ بها ترفا وبطرا وطغيانا على حساب الفقراء والمستضعفين!
كما أن في ذكر دفع الزكاة للفقراء ورفع الظلم عن الضعفاء بعد توحيد الله؛ بيانا لمقاصد التوحيد وغاياته، وهو تحرير الخلق، وتحقيق العدل، ونصرة المستضعفين، ورفع الظلم عنهم، الذي طالما مارسه عليهم الجبابرة والطغاة، الذين نازعوا الله في ملكه وخلقه وعباده.
قال ﷺ: (من وحد الله، وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله، ودمه؛ وحسابه على الله)، وفي رواية: (من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله...).([6])
وقوله: (وكفر بما يعبد من دون الله) يشمل الكفر بكل معبود غير الله، سواء كانوا ملوكا وأوثانا، أو أحبارا ورهبانا؛ إذ أن طاعتهم عبادة لهم واتخاذهم أربابا من دون الله كما سيأتي بيانه.
فحقيقة التوحيد: إفراد الله وحده لا شريك له فيما يجب له؛ وذلك باعتقاد وحدانيته في:
1-الخالقية؛ كقوله تعالى: ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾([7])أي: ليس لغيره معه خلق ولا أمر، وكقوله ﷻ: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾([8]).
2-والربوبية؛ كقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِين﴾([9] )وقوله ﷻ: ﴿بِرَبِّ النَّاس﴾([10])، وقوله ﷻ: ﴿أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾([11]).
3-والألوهية؛ كقوله تعالى: ﴿اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ﴾([12]).
4-وصفات الكمال وأسماء الجلال؛ كقوله ﷻ: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾([13]).
5-والملك؛ كقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُون﴾([14])، وقوله ﷻ: ﴿مَلِكِ النَّاس. إِلَهِ النَّاس﴾([15])، فكما لا إله للناس إلا الله؛ فليس لهم ملك سواه.
6-والحكم؛ كقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ ([16])، وقوله ﷻ: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾([17] )أي: ليس لغيره.
7-والطاعة؛ كقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾ ([18])أي: بأمر الله وحده لا شريك له.
8-والعبادة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون﴾([19])، وكقوله ﷻ: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون﴾([20]).
9-والرهبة والخشية والخوف؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾([21])، وتقديم المفعول يفيد القصر والحصر؛ أي: لا ترهبوا أحدا غيري، وكقوله ﷻ: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُون﴾([22])، وكقوله ﷻ: ﴿فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾([23])، وكقوله في أبرز صفات الموحدين المؤمنين: ﴿وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ﴾([24])، وكقوله في صفات أهل الإيمان: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ﴾([25]).
إلى غير ذلك من صور التوحيد ومعانيه مما أوجب الله على عباده إفراده بها، وحرم عليهم الإشراك به فيها؛ كقوله تعالى في العبادة: ﴿وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾([26])، وقوله في الحكم: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾([27])، وقوله في التشريع: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾([28])، وقوله في الملك: ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾([29])، وفي الطاعة كقوله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون﴾([30]).
فكما أوجب توحيده بكل ما سبق من معاني التوحيد وحقائقه؛ فقد حرم كذلك الإشراك به في كل تلك المعاني.
معنى (إله) في الخطاب القرآني:
وقد جاء بيان هذه اللفظة التي عليها مدار كلمة التوحيد نفيا (لا إله)، وإثباتا (إلا الله)، في آيات كثيرة قطعية في دلالاتها، ومن ذلك إطلاقه على:
1- المعبود من دون الله؛ سواء كان حجرا أو بشرا؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ﴾([31])، وقوله ﷻ: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾([32])، وقوله ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون﴾([33])، وقال مشركو العرب حين تصدوا لدعوة التوحيد ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾([34]).
2- المتبوع من دون الله؛ سواء كان ملكا أو عالما أو هوى؛ كما في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِين﴾([35])، أي: المتبعين غيره، وكما في قولهﷻ: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء﴾([36])، وقوله ﷻ: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء﴾([37])، فجعل كل متبوع من دون الله شريكا وتابعه مشركا، وقوله ﷻ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَاب﴾([38])، وقوله ﷻ: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد﴾([39])، والجبار في لغة العرب: الملك والطاغية، وكما في قوله ﷻ: ﴿فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد﴾([40])، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾([41])، وقوله ﷻ: ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾([42])، وقد صرح القرآن بأن المتبوع من دون الله إله من دون الله عند من اتخذه متبوعا؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾([43])، وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾([44])، فسمّى القرآن الهوى إلها؛ وذلك حين يتبع الإنسان هواه ليجعل من نفسه إلها من دون الله.
3- المطاع من دون الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون﴾([45])، والشرك نقيض التوحيد، والشياطين هنا هم شياطين البشر الذين يجادلون عن الباطل من الرؤساء والعلماء؛ فدل على وجوب إفراد الله وحده بالطاعة، وقال ﷻ: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ﴾([46])، وقال أيضا في بيان أن الغاية من إرسال الرسل أن تكون الطاعة لله وحده وبإذنه وأمره: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ﴾([47])، فالطاعة للرسول إنما وجبت لكونها طاعة لله، إذ الرسول هو المبلغ عن الله؛ كما قال تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾([48])،والفرق بين الطاعة والاتباع أن الطاعة تكون عادة من أدنى لأعلى، كما تقتضي وجود أمر ونهي من الأعلى للأدنى، كطاعة الناس للملوك، بينما الاتباع أعمّ من ذلك، فقد يكون بلا أمر ولا سلطة، كاتباع رجال الدين، واتباع الهوى، واتباع الشهوات، واتباع خطوات الشيطان.
4- المتحاكم إليه من دون الله؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾([49])، وقوله ﷻ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾([50])، وقوله ﷻ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾([51])، وقال أيضا: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾([52])، وفي قراءة سبعية: ﴿وَلاَ تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾.
ومما يؤكد أن (إله) تطلق على كل من تبذل له الطاعة من دون الله؛ قوله تعالى في قصة فرعون ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾([53])، وقال فرعون لموسى: ﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِين﴾([54])، وإنما أراد فرعون من موسى وبني إسرائيل طاعته وعدم الخروج عن سلطته؛ فكانت تلك هي الألوهية التي أرادها لنفسه، وهي الربوبية التي ادعاها في قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾([55])، أي: السيد والملك الذي لي الطاعة عليكم، وهذه هي العبودية التي كان فيها بنو إسرائيل؛ كما في قول الملأ من قوم فرعون: ﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون﴾([56])، أي: خاضعون طائعون لا يخرجون عن سلطتنا.
ويؤيد ذلك قراءة: ﴿وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ﴾([57])، فقد كان لفرعون آلهة يعبدها هو وقومه؛ فدل ذلك على أنه إنما كانت الألوهية التي ادعاها فرعون لنفسه والربوبية التي انتحلها هي اتباع أمره، وطاعته، وعدم الخروج عن سلطته.
قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره: فقال فرعون وملؤه ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ فنتبعها ﴿وَقَوْمُهُمَا﴾ من بني إسرائيل ﴿لَنَا عَابِدُون﴾ يعنون: أنهم لهم مطيعون متذللون، يأتمرون لأمرهم، ويدينون لهم، والعرب تسمي كل من دان لملك عابدا له، ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: العباد؛ لأنهم كانوا أهل طاعة لملوك العجم).
فهذا نص صريح يكشف معنى العبادة والعبودية في لغة العرب، وأن كل من دان لملك وأطاعه؛ فقد عبده وصار عبدا له، فجاء الإسلام بالتوحيد وعبادة الله وحده، والكفر بعبادة كل ما سواه، ومن ذلك طاعة الملوك والرؤساء ورجال الدين.
الفرق بين لفظ (إله) و(رب):
ولفظ (إله) و(رب) إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، فكان لكل منهما معنى أخص به؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس * مَلِكِ النَّاس * إِلَهِ النَّاس﴾، فالرب هو السيد الذي له الأمر والسيادة، والملك هو الذي له الملك والحكم والطاعة، والإله هو الذي له الدعاء والعبادة.
وإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى؛ كقول فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾، وهذا بمعنى قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾، فكل من تبذل له الطاعة والخضوع من دون الله فهو رب وإله عند من خضع له وأطاعه، وهذا كقوله تعالى في شأن طاعة أهل الكتاب لرجال الدين: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾([58])، وكقوله على لسان يوسف ﴿أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار﴾([59])، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾([60])، وكقوله ﷻ: ﴿وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُون﴾([61])؛ فسمى الله كل ما يعبد من دونه، أو يدعى من دونه، أو يطاع من دونه، أو يتبع من دونه؛ ربا وإلها، وكل من فعل ذلك؛ فقد أشرك بالله في ربوبيته وألوهيته.
وبهذا جاءت كلمة التوحيد لتنفي كل صور الألوهية، وكل صور الربوبية، عن كل من سوى الله ﷻ، من بشر أو حجر، ولتبطل كل صور العبودية لغير الله من عبادة أو طاعة أو اتباع أو تحاكم، ولتفرد الله وحده بذلك كله لا إله إلا هو؛ بل ولتوحده أيضا بكل نعوت الكمال وصفات الجمال وأسماء الجلال التي تتعلق بذلك كله -كما سيأتي بيانه- ليقطع الطريق على كل صور الشرك والوثنية والجاهلية.
وقد أكثر القرآن من تقرير وحدانية الله في الخلق، والملك، والحكم، والطاعة، والسيادة، والعبادة؛ لبيان بطلان منازعة الملوك والطغاة له في شيء من خلقه؛ لشيوع هذا الشرك في المجتمعات الإنسانية كافة، فقد كان من أبرز صور الشرك وأظهرها؛ منازعة ملوك الأرض له في ربوبيته، واستعبادهم خلقه؛ ولهذا افتتح الله القرآن بقوله سبحانه: بقوله سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ([62]).
فتضمنت هذه الآيات تأكيد وحدانية الله في ربوبيته للعالمين كافة، وأنه وحده ربهم وسيدهم، لا رب لهم سواه، ولا مالك لهم غيره؛ لكونه خالقهم ورازقهم، ومحييهم ومميتهم، وهو الملك الذي سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم يوم الدين والجزاء، وليس أحد سواه، فملوك الأرض عبيده، ليس لهم من الملك معه شيء؛ ولهذا أوجب على عباده أن يعبدوه وحده، وأن يستعينوا به وحده، فلا يعبدوا الملوك، ولا يتذللوا لهم؛ لأنهم بشر مثلهم، لا يستطيعون نفعا ولا ضرا، ولا خيرا ولا شرا، إلا ما شاء الله وحده.
كما ختم الله القرآن بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس* مَلِكِ النَّاس* إِلَهِ النَّاس﴾([63])؛ ليؤكد الحقيقة نفسها التي افتتح بها كتابه؛ فهو رب الناس وسيدهم الذي تجب له الطاعة وحده، وهو ملك الناس الذي له الملك والحكم وحده، وهو إله الناس الذي تجب له العبادة وحده، وليجيب عن أول سؤال مشكل تواجهه المجتمعات الإنسانية كلها منذ وجدت:
فمن رب الناس وسيدهم الذي له حق الطاعة عليهم؟
ومن ملك الناس الذي له حق الحكم بينهم؟
ومن إله الناس الذي له حق العبادة والتذلل والخشية والرهبة والرغبة؟
وإنما أكد القرآن هذه الحقائق الثلاث؛ لكون الشرك فيها أظهر، والنزاع فيها أشهر، وآثارها على الإنسانية أشد وأخطر؛ خاصة في جاهلية الأمم الأخرى من غير العرب؛ كالفرس والروم.
حقيقة توحيد الله في الحكم واجتناب الطاغوت:
وقرر القرآن هذا الأصل العظيم من أصول الدين من خلال ما يلي:
1- إثبات أن الله هو الحَكَم وإليه الحُكم؛ كما في الحديث الصحيح قال النبي ﷺ لرجل كنيته أبو الحكم: (إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم)([64])؛ فنفى عمّن تكنى بأبي الحكم هذا الاسم وأثبته لله وحده، وأن الحكم لله وحده؛ كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ﴾([65])، وقال سبحانه: ﴿أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ﴾([66])، وقال أيضا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾([67])، وقال كذلك: ﴿وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾([68]).( )
وهذا أوضح بيان أن توحيد الله في الحاكمية أصل لتوحيده في العبادة، فمن لم يثبته؛ فلا توحيد له؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾، و﴿إِنِ﴾ هنا أداة نفي، أي: ما الحكم إلا لله، والنفي (إن)، مع الاستثناء (إلا)، من أقوى أدوات الحصر والقصر في اللغة، المفيدة لمعنى التوحيد والإفراد، وقد جاءت هذه الجملة اسمية لتفيد الثبوت والاستقرار على أنها حقيقة بدهية، ومقدمة ضرورية لما سيتبعها وهو ﴿أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾، فجاءت هذه الجملة الثانية فعلية؛ لما تفيده من التجدد والحدوث، بعد الاسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار؛ لكون التشريع والتحليل والتحريم قد يختلف بين شريعة وأخرى، ولنبي عن آخر؛ كما يأتي التشريع تباعا بحسب النوازل، وقد يدخله النسخ، والتخصيص، وهو يقتضي التجدد؛ بخلاف حق الحاكمية لله، واعتقاد أن الحكم له وحده؛ فهذا وصف مطلق، وحق له وحده، والأمر الوارد في الآية فرع من فروع الحكم، ونوع من أنواعه؛ إذ الحكم منه أمر ونهي وتخيير وإباحة، ولا يُعرف توحيد الله في العبادة، إلا بأحكامه وتشريعاته، وأوامره ونواهيه، وهو ما يقتضي أن يكون توحيده في الحكم قبل توحيده في العبادة، إذ لا يُعرف الشرك من التوحيد إلا بالحكم، ولا تعرف العبادة من العادة إلا بالحكم؛ ولهذا جاز سجود إخوة يوسف له ولم يكن ذلك شركا آنذاك في شريعتهم، ثم أصبح السجود لغير الله شركا في شريعة محمد ﷺ، والأمر كله راجع إلى توحيد الله في الحكم والطاعة، والتسليم المطلق لحكمه، فما حكم بأنه شرك وجب اجتنابه، وما حكم بأنه من توحيده وجب التزامه، وما نسخه من الشرائع وجب اتباعه؛ وهذا معنى الإسلام لله.
وهذا الأصل من أوضح الواضحات، والأصول البينات في الإسلام، ولم يقع فيه خلاف بين الأصوليين؛ كما قال الغزالي في (المستصفى في علم الأصول):(وفي البحث عن الحاكم يتبين أنه لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله ووضعه)([69]).
وقال الآمدي في (الأحكام): (الأصل الأول في الحاكم: اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم به)([70]).
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام): (وتفرد الإله بالطاعة، وكذلك لا حكم إلا له)([71]).
وحتى المعتزلة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين؛ إنما قصدوا قدرة العقل على معرفة حكم الله من حيث العموم، وقبل نزول الشرائع، أما بعد نزول الشرع؛ فلا يخالفون في هذا الأصل، وهو أن الله هو الحاكم لا شريك له، وأن العقل فقط كاشف عن حكم الله، ولا حكم له البتة.
2-كما قرر سبحانه وأخبر أنه لا شريك له في الحكم، وحذر من الإشراك به في الحكم؛ فقال ﷻ: ﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾([72])؛ فهذا على سبيل الإخبار، وفي قراءة سبعية: ﴿وَلاَ تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾؛ وهذا على سبيل الأمر.
3- كما عدّ سبحانه وتعالى طاعة غيره في التشريع والتحليل والتحريم شركا به؛ فقال سبحانه في سورة الشورى وهي مكية: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾([73])، وهو استفهام استنكاري أن يكون هؤلاء الذين يشرعون لعباده من دونه دينا وطاعة لم يأذن الله بها شركاء له في ملكه وسلطانه وطاعته، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون﴾([74]).
وذلك أن قريشا قالت للنبي ﷺ وأصحابه: كيف تأكلون ما ذبحتم بأيديكم، ولا تأكلون ما ذبحه الله لكم وهي الميتة؟ فنزلت الآية؛ لتقرر أن حق التشريع المطلق، والتحليل والتحريم، هو لله وحده، وأن طاعة غيره في هذا الباب شرك به، وفاعله مشرك بالله، وهذا كله في مكة قبل الهجرة؛ مما يؤكد طبيعة الدعوة والخطاب في العهد المكي.
4- وحرم سبحانه التحاكم إلى غيره وعدّه طاغوتا؛ فقال ﷻ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾([75])، وقال أيضا: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾([76])، وقال سبحانه: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾([77])، وقال أيضا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِين. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾([78])، وقال ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾([79]).
فثبت بهذه الآيات أن غاية الرسل كلهم أن يعبد الخلق الله وحده وأن يجتنبوا الطاغوت، ودل القرآن بأن الطاغوت في الآية يشمل كلا الطاغوتين: طاغوت العبادة كالأوثان، وطاغوت الحكم كالملوك، وأن لكل طاغوت أولياؤه ومن يقاتلون دونه!
حقيقة الطاغوت ومعناه:
وكلمة "الطاغوت" أصلها من طغى يطغى طغيا وطغيانا؛ فهو طاغ وطاغية وطاغوت، قال في لسان العرب: (طغى جاوز القدر وغلا في الكفر، وكل من تجاوز حده في العصيان فهو طاغ، (كذبت ثمود بطغواها) أي: بطغيانها، وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾... الطاغوت كل معبود من دون الله جبت وطاغوت، والطاغوت الشيطان، والكاهن، وكل رأس في الضلال، ويكون للأصنام، ويكون من الجن والإنس، وقال ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف اليهوديان، قال الأزهري: وهذا ليس خارجا عما قال أهل اللغة، فإذا اتبعوا أمرهما، فقد أطاعوهما من دون الله، والطواغي من طغى في الكفر وجاوز الحد وهم عظماؤهم وكبراؤهم، والطاغية ملك الروم، والجبار العنيد، والظالم الذي لا يبالي ما أتى، يأكل الناس، ويقهرهم، لا يثنيه تحرج ولا فرق) انتهى.
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: (الطاغوت كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء)أ هـ.
معاني الطاغوت:
وفي النظر في معنى الطاغوت في اللغة يظهر جليًا أنه يطلق على ثلاثة معان رئيسة؛ هي:
1- كل معبود من دون الله، من صنم، ووثن، وحجر، وشجر، وقبر؛ كما تدل عليه آية سورة الزمر: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا﴾([80]).
2- كل من يُتبع أو يُطاع من دون الله، وكل من يحكم بين الناس بغير حكم الله، من كاهن، وعالم، وراهب، وملك، ورئيس؛ كما تدل عليه آية سورة النساء الثانية: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾([81])، فقد نزلت في رجلين اختصما؛ فقال أحدهما: نتحاكم إلى النبي ﷺ، وقال الآخر: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف؛ فنزلت الآية، وهي عامة كما قال ابن كثير في تفسيره: "فكل من جعل من نفسه حكمًا، يحكم بين الناس بغير حكم الله؛ فهو طاغوت"، وقد جعل الله مجرد إرادة التحاكم إلى غيره كفرًا، دع عنك التحاكم ذاته، وفي قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ﴾([82]) دلالة على أن من لا يريد التحاكم لغير الله ولا يرضاه لا يدخل في الوعيد الوارد في الآية، حتى لو حوكم قهرًا لغير حكم الله؛ كما هو حال الأمة اليوم.
3- كل جبار ظالم يقهر الناس ويسيطر عليهم بالقوة؛ كقيصر الروم، وكسرى الفرس، ومن على شاكلتهما؛ فهو طاغية وطاغوت؛ كما تدل عليه آية النساء الثانية ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾([83])، فقد دعا الله في هذه الآية المؤمنين إلى الجهاد في سبيله، والجهاد في سبيل المستضعفين من الرجال، والنساء، والولدان، الذين يتعرضون للظلم، والاضطهاد في مكة، على يد طواغيتها، كأبي جهل فرعون هذه الأمة، ومن على شاكلته.
وقد دلت آية النحل: ﴿... وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾([84])على وروده في الأمرين جميعًا في العبادة وفي التشريع؛ فقد احتج المشركون في مكة على النبي ﷺ بالجبر، وبالقدر الكوني، فقالوا: لو شاء الله ما عبدنا نحن وآباؤنا هذه الأصنام والأوثان، ولا أطعنا في التحريم والتحليل الرؤساء والكهان، فرد عليهم القرآن وكذبهم في دعواهم هذه، بأن كل الرسل إنما بعثهم الله ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده، وطاعته وحده، واجتناب الطاغوت كله؛ سواء طاغوت الدعاء والعبادة، أو طاغوت الحكم والطاعة، وهم قادرون على فعل هذا وهذا، فلم يأمرهم الله بالشرك به، ولا أجبرهم عليه. بل جعل لهم القدرة والإرادة والحرية في الاختيار، وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب؛ لبيان صراطه المستقيم، وسبيله القويم، فلا حجة لهم بعد ذلك على الله.
فإذا كان الله قد أكد أنه هو خالق كل شيء، وأنه له الخلق والأمر، وهو الملك، وله الملك وحده، وليس له شريك في الملك، وإذا كان هو الرب، ورب العالمين، ولا رب سواه، والسيد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا كان هو وحده الذي له الحكم، ولا يشرك في حكمه أحدًا؛ فماذا بقي لملوك الأرض معه؟ وعلى أي أساس يدعون الملك؟ وبأي حق يحكمون الناس؟ وكيف يتحاكم لهم العباد؟
إنه لا يتصور أن يقرر القرآن كل هذه الحقائق، ثم يقرر مشروعية وجود الملوك، ويسوغ سلطتهم على العباد، كيف وقد ثبت([85])أن قيام الملك العضوض، والملك الجبري، ما هو إلا انحراف عن هدي النبوة والخلافة الراشدة، ومخالفة لما جاء به الإسلام من أصول عقائدية وعملية، واتباع لسنن القياصرة والأكاسرة؟
لقد جاء الإسلام بالخلافة، والشورى؛ ليهدم الملك والاستبداد، والظلم والاستعباد، وليبطل سنن كسرى وقيصر، وليحرر الخلق كافة من عبوديتهم، وعبادتهم، وطاعتهم، وجورهم وظلمهم، وليقيم لهم دولة العدل والقسط، والعلم والحق، والمساواة والحرية، والرحمة والإنسانية.
الأصل الثاني: توحيد الإنسانية وتكريم البشرية واستخلافهم في الأرض:
وهذا هو الأصل الثاني من أصول الخطاب السياسي القرآني، فبعد الدعوة لتوحيد الله وحده لا شريك له في كل ما يجب له، ثنى بالإنسان، وبيّن حقيقة وجوده، والغاية منها، ومكانته في الوجود، ومهمته، وعلاقته بالله، وبالأرض، وبمجتمعه، وبأخيه الإنسان، وقد جاء تقرير هذا الأصل، وتكرير تأكيده في آيات كثيرة، على أنحاء مختلفة؛ ومن ذلك:
1- تأكيد القرآن أن جنس الإنسان خليفة لله في الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾([86])، وفي هذا اختصاص للنوع الإنساني باستعمار الأرض وإصلاحها؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾([87]).
2- وأثبت أن الإنسانية كلها من أصل واحد، ومن أب واحد وأم واحدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى؛ فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾.([88])
3- وأكد أن المقصود من جعل الناس شعوبًا وقبائل؛ ليتعارفوا ويتآلفوا، ويتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان؛ فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.([89])
4- كما أكد تكريم الله للإنسان، فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا﴾.([90])
5-وأكد أنه لا فرق بين أمة وأمة، وجنس وجنس، ولون ولون؛ فلا فرق بين أبيض وأسود، ولا عربي وعجمي، ولا ذكر وأنثى، إلا بالتقوى، وأن الناس سواسية كأسنان المشط؛ كما ثبت ذلك كله أيضا في الخطاب النبوي([91]).
6- وقرر حرمة النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليها، وأن من قتل نفسا واحدة كمثل من قتل الناس جميعًا، ومن أحياها كمثل من أحيا الناس جميعًا؛ فقال تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾([92]).
7- ووعد الله عباده المؤمنين المصلحين بالاستخلاف الخاص في الأرض؛ فقال سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾([93]).
فأخبرت هذه الآية، وأكد هذا القول الصدق والوعد الحق، أن الاستخلاف الخاص هو للمؤمنين كافة؛ كما جاء الوعد بأن الأرض ستكون لهم؛ فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون﴾([94])، وجاء في الحديث الصحيح: «إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها»([95])؛ فجعل الأرض التي دخلت الإسلام ملكًا لأمته كلها.
وكل هذه الحقائق القرآنية التي تؤكد استخلاف الله للإنسان في الأرض، وتؤكد تكريم الله له، وأن الإنسانية كلها من أصل واحد، وأن الغاية من خلقهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، ويتعاونوا ويتآلفوا، ويعمروا الأرض، كل ذلك جاء به الخطاب القرآني ليهدم القيم الجاهلية التي كانت وما زالت تقوم عليها المجتمعات البشرية، كالطبقية، والعصبية، والقومية، والعنصرية، واستعباد الأقوياء للضعفاء، واستغلال الأغنياء للفقراء، واحتقار الرجال للنساء، إلى غير ذلك من المفاهيم الجاهلية التي يستعبد فيها الإنسان أخاه الإنسان؛ ظلمًا وعدوانًا، بسبب الانحراف عما جاء به الأنبياء الذين دعوا الأمم إلى الأخوة الإنسانية والمساواة، وإلى الرحمة والعدل والمواساة.
الأصل الثالث: تحرير الإنسانية وتجريد العبودية:
فلم يقتصر الخطاب القرآني على الدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له، واعتقاد وحدانيته فيما يجب له -كما بيناه في الأصل الأول الذي هو خاص فيما يجب لله - بل دعا أيضا إلى تحقيق الحرية الإنسانية، وتحرير الإنسان من كل صور العبودية لغير الله، وجعل ذلك غاية شرعية في حد ذاتها. بل جعل الحرية من أشرف مقاصد كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، فالعبودية إنما هي لله وحده، ثم الخلق بعد ذلك أحرار مع من سواه، فالخضوع، والطاعة، والرغبة، والرهبة، والتذلل؛ كل ذلك لله وحده الذي له الخلق، والملك، والأمر، والحكم، كما قال: ﴿وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾([96])، وقد فسر النبي ﷺ معنى الربوبية هنا بطاعة الرؤساء والأحبار والرهبان والخضوع لهم، وجاء في الحديث: «إنما السيد الله»([97])؛ فهو الذي له وحده السيادة المطلقة.
فإذا كان السيد هو الله، وهو الملك، والرب، والحاكم؛ ليس للخلق على بعضهم سيادة، ولا طاعة، ولا حكم، ولا خضوع، ولا سلطة، إلا بإذن الله. بل حتى الرسل ليس لهم طاعة إلا بإذن الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ﴾([98])، وهذا هو معنى الحرية الإنسانية، وقد تقرر في الشريعة قاعدة (الأصل في الإنسان الحرية)([99])، وأما الرق فهو طارئ يجب العمل على التخلص منه، إذ أكثر الأحكام الشرعية وأجلها وأشرفها منوطة بالحرية، كالإمامة العامة، والجهاد، والجمعة، والجماعة، والحج، والزكاة؛ فكلها يشترط في وجوبها الحرية، وتسقط في حال العبودية والاسترقاق؛ ولهذا أمر النبي ﷺ بتحرير رقيق العرب، فقام عمر في خلافته سنة 17هـ بتحرير كل عربي تم استرقاقه في الجاهلية، ودفع ثمن ذلك من بيت المال، فكان العرب أول أمة في التاريخ الإنساني تتخلص من الرق بشكل نهائي، ومن جميع أشكاله وصوره، وتحققت فيهم الحرية بنوعيها:
1- الحرية المعنوية بالعبودية لله وحده لا شريك له، التي يشترك فيها الجميع الأحرار والرقيق.
2- والحرية الصورية بالتخلص من الرق كله بالنسبة للعرب؛ فلم يبق فيهم عبد ولا رقيق منذ عهد عمر؛ وإنما بقي الرقيق من غير العرب؛ لسببين هما:
1- أن العربي يرجع بعد تحريره إلى عشيرة وأصل وعصبية تقوم به، وتعينه على الاستقلال بنفسه، والقيام بمصالحه، وتوفير المال له، وتزويجه، فلا يواجه مشكلة في الاندماج بالمجتمع، والانصهار به، أما الرقيق من غير العرب؛ فقد يكون تحريرهم دفعة واحدة ضررًا عليهم، إذ لا يرجعون إلى أصل وعشيرة تقوم بهم، ولا يجدون من المال ما يستقلون به؛ فكان بقاؤهم مع مواليهم في صالحهم، حتى إذا قدروا على الاستقلال وكسب المال، وأرادوا عتق أنفسهم كان السبيل أمامهم مفتوحًا بالمكاتبة، إذ كان بعض العرب في الجاهلية يملكون من الرقيق والعبيد المئات. بل الآلاف، وقد لا يستطيع بعض الرقيق أن يستغني عن مواليه، ولا يقدر على الاستقلال بنفسه، إذ لن يكون أحد مسئولا عن القيام به عند تحريره، إذ لا عشيرة له ولا عصبية؛ فيكون عبئًا على المجتمع، وقد يكون بقاؤه معهم أرفق به وأوفق، ثم جعل الشارع بعد ذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، فكل من أعتق رقيقًا صار مولى له، ليندمج الرقيق بعد تحريرهم مع مواليهم، وتكون بينهم علاقة كعلاقة النسب.
2- ولكون الأمم الأخرى تسترق أسراها في الحروب؛ فكان العرب الفاتحون يعاملونهم بالمثل؛ إذ الاسترقاق أهون من القتل، ومع ذلك جعلت الشريعة تحرير الرقيق عمومًا من أفضل القربات، وكفارة للمحظورات، سواء كان الرقيق مسلمين أو غير مسلمين، ككفارة الظهار، والقتل، والحنث بالحلف؛ بل لقد جعل الله تحرير الإنسان كإحيائه من الموت؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾( [100])، فكأن من حرر إنسانًا فقد أحياه، كما أمر القرآن بتحريرهم من بيت مال المسلمين، كما في قوله تعالى في مصارف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ... وَفِي الرِّقَابِ﴾([101])، أي: في اعتاق الرقيق وتحريرهم، وأوجب على السادة مكاتبة من يريد فداء نفسه منهم، ومساعدتهم بالمال؛ كي يتحرر من الرق؛ كما قال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾([102])، وقد ثبت بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يوجب على السيد مكاتبة رقيقه إذا طلب المكاتبة، ويضرب من يأبى ذلك منهم؛ كما فعل مع أنس بن مالك حين أبى أن يكاتب رقيقه.([103])
وكل ذلك يؤكد مدى عناية الشريعة بحرية الإنسان وتحريره من كل أشكال العبودية لغير الله تحريرا ماديًا ومعنويًا؛ ولهذا قال عمر كلمته الخالدة دفاعًا عن قبطي مسيحي ظلمه بعض الأمراء: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)( [104])، فسمى عمر الظلم استعبادًا، مع أن القبطي لم يكن عبدًا ولا رقيقًا؛ بل كان حرًا إلا أن استذلاله وظلمه استعباد معنوي له؛ فالعرب تسمي كل تذلل وخضوع للغير عبودية، وإن كان الخاضع لغيره حرًا في نفسه، إذ هي حرية صورية شكلية لا قيمة لها، وإنما قيمة الحرية حين يعيش الإنسان عزيزًا كريمًا لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا؛ ولهذا قال ربعي بن عامر لرستم: (إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد)([105])، ومعنى عبادة العباد؛ أي: الخضوع والطاعة للملوك والرؤساء والأحبار والرهبان؛ ومنه قول موسى لفرعون ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل﴾([106])، ولم يكن بنو إسرائيل رقيقًا لفرعون؛ بل كانوا أحرارًا؛ غير أنهم لما كانوا خاضعين لحكمه، مستسلمين لظلمه، صدق عليهم أنهم عبيد لا أحرار؛ بل جعل الإسلام هذه الحرية المعنوية من أصول الدين وقطعياته؛ فلا عبودية إلا لله، ولا سيادة إلا لله، ولا طاعة إلا لله، ولا خضوع ولا تذلل إلا له وحده. بينما جعل العبودية الصورية الشكلية وهي الاسترقاق من فروع الأحكام الفقهية؛ وذلك لعظم خطر الحرية المعنوية، وشدة أثرها على النفس البشرية، وخطورتها على المجتمعات الإنسانية!
لقد جعل القرآن هذا التحرير المعنوي غاية التوحيد وأصل الدين؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾([107])، وهذه الربوبية فسرها القرآن بالطاعة والخضوع لغير الله؛ كما في قوله: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون﴾([108])، ومعلوم أنهم لم يعبدوا أحبارهم ورهبانهم بالمعنى العرفي للعبادة، وإنما أطاعوهم وخضعوا لسلطانهم الديني برضاهم واختيارهم دون إكراه؛ فكان ذلك الخضوع الطوعي هو عبادتهم واتخاذهم أربابًا؛ وهكذا فسرها النبي ﷺ لعدي بن حاتم عندما قال: (يا رسول الله إننا لم نعبدهم ؛ فقال النبي ﷺ: «ألم يكن يحرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتطيعوهم؟ قال بلى! فقال النبي ﷺ: فتلك عبادتهم»( [109]).
قال ابن كثير في تفسير الآية: (قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير الآية: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا...ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ﴾ أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما أحله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ) ا. هـ.
وإذا كانت العبودية تناقض الحرية، فالقرآن إذن إنما جاء لتحرير الإنسان من كل أشكال العبودية للإنسان، ومن كل صور العبودية لغير الله، سواء العبودية للملوك والرؤساء، أو السادة والعلماء، أو الشهوات والأهواء، وذلك بإخلاص التوحيد -الذي يقتضي الحرية- لله وحده.
وقد قالت أم مريم: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾([110])، أي: موحدًا، ومخلصًا لك في طاعته، وعبوديته، وتوحيده، وإنما أرادت أن تجعل المولود خادمًا لله وحده في المعبد، لا يخدم أحدًا، ولا يشتغل بطاعة أحد، ولا يخضع لجلال أحد من البشر؛ بل يقصر طاعته لله وحده، فقالت: ﴿مُحَرَّرًا﴾؛ فجعلت التحرير نظير التوحيد، فالحرية هنا تعني التوحيد الخالص لله.
ومما يرسخ مفهوم الحرية الإنسانية الذي جاء به القرآن قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾([111])، والدين هنا: بمعنى: الطاعة والخضوع، فلا إكراه في طاعة الله وعبادته في الإسلام؛ بل الطاعة قائمة على أساس الحرية لا الإكراه، وإذا كان الله لم يرض من عباده أن يطيعوه أو يعبدوه أو يوحدوه كرهًا؛ فكيف يسوغ للملوك والرؤساء أن يجبروا الناس على طاعتهم والخضوع لسلطانهم بالإكراه دون رضاهم؟.
وكيف تأتي الشريعة العملية بما يتناقض مع الأصول العقائدية؟.
والعرب تطلق الدين وتريد به الطاعة؛ كما في قول عمرو بن كلثوم:
وأيـام لنـا غـر طــوال *** عصينا الملك فيها أن (ندينا)
إذا ما الملك سام الناس خسفا *** أبينا أن نقر الخسف فينا
وقال سعد بن ناشب المازني:
فلا تـوعـدنا يا بـلال فـإننـا *** وإن نحن لم نشقق عصى (الدين) أحرار
وعصى الدين هنا؛ أي: عصى الطاعة.
فقوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ أي: لا إكراه في الطاعة، وعدم الإكراه هو الحرية؛ ولهذا كانت حرية الاختيار وعدم الإجبار شرطًا في التكليف كما عند الأصوليين والفقهاء بلا خلاف، ولا اعتبار بما صدر عن الإنسان حال الإكراه؛ كما في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
ولهذا استعمل الفقهاء والعلماء كلمة (مختار) و(اختيار) وشاعت في استعمالهم، بدلًا من (حر) و (حرية)؛ لكون الاختيار ينافي الإكراه، وهو بمعنى الحرية؛ بل قد يكون الإنسان حرًا، ولا اختيار له؛ بينما الأحكام الشرعية كلها يشترط فيها ولها الاختيار وعدم الإكراه.
بل إن مفهوم التوحيد الذي جاء به القرآن ليتسع حتى يشمل تحرير الإنسان حتى من الشعور النفسي؛ كالخوف من غير الله، والخشية، والرهبة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين﴾([112])، فشرط لتحقيق الإيمان به عدم الخوف من غيره، ومن كل ما سوى الله، كما قال: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾([113])، وهو كقوله: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون﴾([114])، فكما لا تكون العبادة إلا لله وحده؛ فكذلك لا يكون الخوف والرهبة والخشية إلا منه وحده؛ لأنه هو الذي يخلق الخلق، ويهب الرزق، ويحيي ويميت؛ فاستحق وحده الخضوع والخشية، والرهبة والرغبة، والعبادة والطاعة، فالتوحيد الكامل يساوي التحرير الكامل للنفس البشرية من كل أشكال العبودية لغير الله.
وقد اهتم النبي ﷺ غاية الاهتمام في ترسيخ مفهوم تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية لغير الله حتى نهى أصحابه عن القيام له إذا دخل عليهم كما يفعل العبيد مع أسيادهم، ونهاهم عن الوقوف على رأسه وهو جالس حتى وهو يصلي؛ تجنبا لسنن الرؤساء والملوك، ونهاهم عن الانحناء له؛ بل نهاهم أن يقول أحدهم لرقيقه ومملوكه: (عبدي وأمتي). بل يقول: (فتاي وفتاتي)، وعلل ذلك بقوله: «فكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله»([115]).
الأصل الرابع: دعوة الخلق إلى العدل والحق:
لقد جاء الإسلام وقد ملئت الأرض جورًا وظلمًا، على أيدي الطغاة في كل مكان، والإنسانية تعج بكل أشكال الظلم والطغيان، والمجتمعات البشرية تضج بأسوأ صور البؤس والشقاء، وسيادة شريعة الغاب، وقد كان للعرب في جاهليتهم نصيب وافر من ذلك الظلم والتظالم؛ فكان القوي يأكل الضعيف، ويرابي الغني الفقير، ويفتك بعضهم ببعض، وقد شاع فيهم الظلم حتى صار ممدوحًا عندهم؛ وحتى قال شاعرهم:
قُبيّلة لا يخـفرون بذمـةٍ *** ولا يظلمون الناس حبة خردل!
يذمهم لعدم ظلمهم للناس، إذ عدم وقوعه منهم دليل على ضعفهم وخورهم، في ثقافة العرب الجاهليين!
وحتى قال آخر يذم قبيلته لعدم وقوع الشر منهم:
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي *** بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم *** طاروا إليه زرافـات ووحـدانا
لا يسألون أخاهم حين يندبهم *** في النائبات على ما قال برهانا!
إني وإن كنت من قوم ذوي عدد *** ليسوا من الشر في شيء وإن هانا!
يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة *** وبالإسـاءة غفـرانا وإحسانا
ففي هذه الأبيات تصوير بليغ لحال المجتمع الجاهلي، ولشيوع التظالم فيه، حتى صار الممدوح فيهم من لا يسأل أخاه عن البينة فيما ادعاه من وقوع الظلم عليه؛ لشيوعه فيهم، وحتى صار الكريم من لا يستفسر عن السبب؛ بل يبادر إلى رد الظلم عند سماع الصريخ، وكأن الصريخ لا يقع، إلا من ظلم قد وقع!.
بل صاروا يتفاخرون بالتظالم، والاعتداء، والعدوان، حتى على أبناء العمومة، كما قال شاعرهم:
وأحيانا على بكر أخينا *** إذا ما لم نجد إلا أخانا!
لقد كان العرب الأقوياء يتناصفون إذا تظالموا بشن الغارات، وأخذ الثارات، غير أن الأمم الأخرى كانت تحت عسف الطغاة، وجبروتهم، وظلمهم؛ فبعث الله للخلق كافة نبي الإنسانية والرحـمة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين﴾([116])، وجعل إقامة العدل هو الغاية من إرساله ﷺ، وإرسال الرسل من قبله، والغاية من إنزال الكتب معهم؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾([117]).
فأرسل الله ﷻرسوله ﷺ بالكتاب والميزان؛ رحمة للعالمين، ليقوم الناس بالعدل والقسط؛ بل لقد جعل الله الغاية من خلق الخلق تحقيق العدل؛ كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَن* عَلَّمَ الْقُرْآن * خَلَقَ الإِنسَان * عَلَّمَهُ الْبَيَان... وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان * أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَان * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَان﴾([118])، فهذه سورة مكية، افتتحها الله باسمه (الرحمن)، وذكر الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ومن أجلها رفع السماء؛ وهي أن يتحقق العدل والقسط، ثم دعا عباده إلى إقامة العدل والقسط فيما بينهم وبين ربهم بتوحيده، وإقامة القسط فيما بينهم بالتناصف وعدم التظالم، وقد جاء القرآن المكي بالدعوة إلى توحيد الله وعدم الإشراك به وهو من الظلم؛ بل أشد أنواعه، كما دعا إلى إقامة العدل، وإنصاف المظلوم، ونصر الضعيف، والرحمة بالخلق؛ بل لقد قدم القرآن المكي الدعوة إلى القسط على توحيد الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾([119]).
ومما يؤكد أن القسط والعدل مقدمان على ما سواهما؛ هو إقرار الإسلام وقبوله في دولته وسلطانه بقاء أهل الأديان الأخرى على أديانهم وعدم إكراههم على تركها؛ إذ المقصود إقامة العدل والقسط فيهم؛ كما قال تعالى على لسان رسوله ﷺ: ﴿وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾([120])؛ لكونه مبعوثًا رحمة للعالمين كلهم مؤمنهم وكافرهم، والرحمة بالكافر تتمثل في عدم إكراهه على الإيمان، وفي العدل والقسط معه، وعدم ظلمه، والرأفة والرفق به، والإحسان إليه، للأخوة الإنسانية التي تجمع بين الإنسانية كلها؛ ولهذا جاء في الحديث أنه قيل له ﷺ: ادع على المشركين يا رسول الله! فقال ﷺ: «إني لم أبعث لعانًا، وإنما بعثت رحمة»([121])، وقال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من في السماء»([122]).
لقد دعا القرآن إلى العدل والقسط حتى مع الأعداء، وجعل العدل معهم واجبًا ودينًا وإيمانًا، وحرم الظلم مطلقًا؛ كما قال على لسان النبي ﷺ وهو في مكة: ﴿وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾([123])، وقال أيضا في وجوب العدل مع العدو ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾([124])، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾.([125])
وقد قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل وهي هذه الآية.
بل ولم يقتصر القرآن على الدعوة إلى العدل والقسط مع غير المسلمين؛ وإنما دعا إلى البر بهم والإحسان إليهم؛ كما قال تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين﴾([126]).
وأمر بالحكم بالقسط بينهم فقال: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾([127]).
لقد كان تحقيق العدل والقسط هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وكما قال ابن القيم: "فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه؛ بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين"([128]).
صور الظلم في المجتمعات الجاهلية:
وقد نعى القرآن على المشركين ما هم فيه من ظلم وتظالم، حيث كان الظلم فاشيًا فيهم بكل صوره وأشكاله، فمن ذلك:
1ـ الظلم الاقتصادي الذي كان يمارسه الأغنياء في معاملاتهم التجارية في البيع والشراء، وأكثر ضحاياه الفقراء والضعفاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِين. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُون. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُون. أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُون. لِيَوْمٍ عَظِيم. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين﴾([129]).
لقد كانت هذه الدعوة أصل عظيم في خطاب شعيب لقومه؛ بل القضية الرئيسة فيه بعد الدعوة إلى التوحيد؛ كما في قوله تعالى عنه: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيط. وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين﴾([130]).
وقال أيضا: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِين. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم. وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين﴾([131]).
وقد رد قومه عليه بسخرية: ﴿قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء﴾([132])أي: هل دينك وعبادتك لربك يفرضان علينا أن نترك عبادة الأوثان، وألا نفعل في أموالنا من نشاء، من بيع وشراء، وتطفيف للميزان، وظلم للضعفاء والفقراء؟
لقد أدرك قوم شعيب أن دين شعيب لا يقبل الفصل بين الشرك والظلم؛ فكلاهما اعتداء، ذاك على حق الله، وهذا على حق العباد، وإنما جاء الرسل بالعدل والقسط، والرحمة بالخلق، ومازال هذا الظلم -الذي حاربه رسل الله جميعًا موسى، وشعيب، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم جميعًا- هو أحد أسباب شقاء المجتمعات الإنسانية إلى اليوم، حيث يموت الملايين جوعًا ومرضًا وفقرًا؛ بسبب الظلم الاقتصادي، والربا، والغش، وأكل الأقوياء والأغنياء أقوات الضعفاء والفقراء، ويشترك في هذه الجريمة بحق الإنسانية حتى رجال الدين؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم﴾([133]).
وقال تعالى في شأن اليهود وأنه عاقبهم بسبب ظلمهم: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾([134]).
2ـ الظلم الاجتماعي بكل صوره وأشكاله؛ كظلم اليتيم، وظلم المرأة، وظلم الفقير، وظلم الضعيف؛ كما في قوله تعالى: ﴿كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيم. وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾([135]).
وقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيم. وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّين. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُون. الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون﴾([136])، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَر﴾([137]).
وحث على الصدقة على الفقراء والمساكين، وجعل ذلك سبيلًا إلى دخول الجنة؛ كما جعل حرمانهم وعدم مد يد العون لهم سبيلًا وسببًا لدخول النار؛ فقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى... فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَشْقَى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾.([138])
وقال تعالى: ﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَة. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة. فَكُّ رَقَبَة. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة﴾.([139])فوعد من آمنوا به، وتواصوا بالرحمة بالخلق، وبالصدقة على المحتاجين؛ بأنهم سيجتازون عقبة جهنم، وسيدخلون الجنة.
وقال تعالى عن دخول المشركين النار وتحاججهم فيها بأن سببه تركهم للصلاة؛ التي هي حق الله على عباده، وتركهم الصدقة على الفقراء، التي هي حق الإنسان على أخيه الإنسان، وإن لم يكن على دينه؛ إذ الرحمة تشمل الجميع؛ قال: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين﴾([140]).
فجعل جريمة عدم إطعام الفقير؛ كجريمة ترك عبادة الله، وجعل القتال في سبيل الضعفاء والمظلومين؛ كالقتال في سبيل الله ونصرة الدين؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ﴾.([141])
لقد دعا القرآن إلى كل ما سبق ذكره في العهد المكي، وفي الخطاب المكي، فالرحمة باليتيم، والضعيف، والعطف على المساكين، والمحتاجين، والإنفاق عليهم؛ من القضايا الرئيسة في مكة، مع أن الخطاب موجه للمشركين، ومع أن تلك الفئات المحرومة أيضًا من المشركين، إلا أن الدعوة إلى توحيد الله ﷻ، تزامنت وارتبطت بالدعوة إلى الرحمة بالخلق، وإقامة العدل والقسط بينهم، وهو الغاية من إرسال الرسل، وإنزال الكتب.
كما قال تعالى في شأن ظلم المرأة ووأد بعض أهل الجاهلية بناتهم: ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَت. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت﴾([142]).
وقد كان العرب في جاهليتهم يحتقرون المرأة؛ كما قال عمر بن الخطاب: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم)( [143]).
وقال تعالى في شأن الأسير، وأن الرحمة به، وإطعامه؛ سبب لدخول الجنة ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُورًا﴾([144])
ففي هذه السور -وعامتها سور مكية إلا سورة الإنسان فهي مدنية- نعي شديد على المشركين من أهل مكة ما هم فيه من ظلم اجتماعي، صار ضحيته الأيتام، والمساكين، والضعفاء، والنساء؛ بسبب الرأسمالية الجشعة، وعبادة المال، التي لا يهمها إلا جمعه، وعبادته، وحبه حبًا جمًا، وإن كان على حساب المساكين والمستضعفين.
3ـ الظلم الطبقي: فقد جاء القرآن ليحطم القيم الجاهلية الظالمة التي تفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس طبقي؛ فحذر الله النبي ﷺ من الانصراف عن الضعفاء، والمستضعفين؛ لأجل كسب رضا الملأ المستكبرين؛ فقال: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِين. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَçؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِين﴾([145]).
ودعاه إلى الصبر معهم؛ فقال: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾([146]).
وقد كان سبب نزول هذه الآية- كما في صحيح مسلم - أن أشراف قريش طلبوا من النبي ﷺ أن يجعل لهم مجلسًا خاصًا بهم، وأن لا يحضر معهم الضعفاء؛ كبلال الحبشي، وخباب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وصهيب الرومي؛ حتى لا يجترأ هؤلاء الضعفاء على الملأ، وحتى يتسنى للأشراف والسادة أن يستمعوا لدعوته، إذا أقصى الضعفاء عنه؛ فحذره سبحانه من قبول طلبهم، وأمره أن يلزم الجلوس معهم، وأن لا يمد عينيه إلى مجالس أهل الشرف والثروة، ما داموا على جاهليتهم، واستكبارهم، وطغيانهم؛ ليهدم بذلك كل قيم الجاهلية الزائفة الخاطئة؛ كما حذره الله من أن الانصراف عن دعوة ابن أم مكتوم الأعمى الضعيف، ولو من أجل دعوة الوليد بن المغيرة السيد الشريف؛ فقال في شأنهما: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَن جَاءهُ الأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى﴾([147]).
وقد ضرب الله المثل في فرعون وطغيانه الطبقي؛ كما في قوله تعالى في شأن فرعون وظلمه لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِين. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِين﴾([148]).
لقد كانت هذه الدعوة إلى إقامة القسط وتحقيق العدل والمساواة والرحمة بالخلق، قضية رئيسة في الخطاب القرآني في العهد المكي، ثم المدني.
فكان الإسلام بهذه المبادئ السماوية ثورة على كل الأوضاع الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والدينية، التي كان عليها العرب، والأمم الأخرى في الجاهلية، والتي كانت ظلمًا وجورًا؛ فجاء النبي ﷺ بهداية السماء؛ ليقيم لهم على أنقاضها مجتمع الإنسانية، والعدل والحرية، ويحقق المساواة بينهم في كل شئون الحياة؛ إذ هذه هي الغاية من إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾([149])، وقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾([150]).
الأصل الخامس: الأخوة الإيمانية والسلطة الشورية:
لقد بشر القرآن في العهد المكي بقرب قيام المجتمع الإنساني الإيماني؛ كما في قوله تعالى في سورة الشورى وهي مكية: ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُون. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُون. وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِين. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُور﴾([151]).
لقد نزلت هذه الآيات في مكة قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة النبوية؛ وهي تتحدث عن أبرز صفات المجتمع الإسلامي الجديد الذي سيقوم على أنقاض المجتمع المكي الجاهلي الذي يقوم على ظلم الناس، والبغي في الأرض بغير الحق بالعدوان على الضعفاء، والفقراء، والعبيد، والنساء، ويقوم على الطبقية البغيضة حيث كانت الشورى في مكة مقصورة على الملأ والأشراف من قريش؛ فكانوا يتشاورون في(دار الندوة)، ولم يكن للضعفاء، والموالي، والنساء، حق في تلك الشورى الجاهلية؛ فجاء قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون﴾ لتبشر الآية؛ بل سورة الشورى كلها، بقرب قيام المجتمع الإنساني الإيماني الذي لا طبقية فيه، ولا جاهلية، ولا عنجهية؛ بل يقوم على الأخوة، فأمر المؤمنين شورى بينهم لا فرق في ذلك بين حر وعبد، ورجل وامرأة، ولا وضيع وشريف، أو قوي وضعيف، ولا بين غني وفقير، أو كبير وصغير؛ بل كل من استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة؛ فأمرهم شورى بينهم؛ فهي من أبرز خصائص المجتمع الإسلامي الذي كان يتشكل في مكة قبل أن تقوم له دولة في المدينة.
لقد جاءت آية الشورى بصيغة الجملة الاسمية فـ(أمرهم) مبتدأ، و(شورى بينهم) خبره؛ لتفيد الثبوت والاستقرار، وكأن هذه الصفة لا تنفك، ولا يتصور أن تنفك عن ممارسة المجتمع الإيماني لشئون حياته؛ فلا استبداد بالرأي، ولا استئثار بالسلطة، ولا أثرة بالثروة، ولا طبقية في المجتمع الجديد، وقد أضاف القرآن الأمر للمؤمنين إضافة اختصاص واستحقاق؛ فقال: ﴿وَأَمْرُهُمْ﴾؛ ليؤكد أن الأمر للمؤمنين جميعًا لا لغيرهم من الملوك والطغاة، ولا لفئة خاصة منهم؛ بل هم فيه جميعًا شركاء على حد سواء؛ فلا تختص به فئة، ولا طائفة، ولا قبيلة، ولا أسرة، ولا حزب، ولا قومية.
كما أن هذه الإضافة أفادت العموم كما هو معلوم في علم البيان وأصول الفقه؛ فقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ﴾؛ يشمل كل أمورهم، ويدخل في الأمر دخولًا أوليًا الإمارة والخلافة؛ فهي رأس الأمر كله، والعرب تطلق كلمة (أمر) وتقصد السلطة والرئاسة، فيقولون (تقلد أمرهم)، أي: رئاستهم، وزعامتهم، وإمارتهم، ومنه قول الشاعر الجاهلي لقيط الإيادي في قصيدته لقومه حيث يقول:
وقلدوا أمـركم لله دركـمُ *** رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
وكما في قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾، فالمقصود بأولي الأمر هنا: الأمراء الذين تجب طاعتهم في طاعة الله ورسوله، وسيأتي تفصيل القول فيه في الأصول العملية.
والمقصود هو أن الأخوّة الإيمانية أخصّ من الأخوّة الإنسانية، فالمجتمع الإسلامي تقوم العلاقة بين أفراده على أساس الأخوّة، التي تقتضي المساواة التامة بين كل أفراده؛ بالإضافة إلى ما تقتضيه الأخوة من تعاطف، وتراحم، وتعاضد؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾([152])، وكما في الحديث الصحيح: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»([153])، وكما في الحديث الآخر: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»([154])، وكما في قوله: ﷺ «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم»([155])، وكما قال في شأن النساء المؤمنات: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾([156])، وفي الحديث: «إنما النساء شقائق الرجال»([157]).
وهذه الأخوّة التي تقتضي المساواة تقتضي أيضا ألا يستبد أحد بأمر أحد، ولا يستأثر أحد بشيء دون أحد، إلا بالحق والعدل والقسط؛ إذ لا فرق بين آحاد المؤمنين، ولا تمايز بينهم، ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح.
وكل هذه المعاني والقيم لم تسمع بها الأمم من قبل حتى جاء بها الإسلام، وظهر على كل الأديان بهذه القيم الإنسانية السماوية.
لقد كان أول عمل قام به النبي ﷺ حين دخل المدينة بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ ليؤكد طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع الجديد، وأنها قائمة على مبدأ الأخوة، فلا أشراف وسوقة، ولا أحرار وعبيد، ولا أقوياء وضعفاء، ولا طبقية، ولا فئوية، ولا طائفية، ولا عصبية؛ بل الجميع في الأخوة والدين سواء، يصلون جميعًا، ويتشاورون جميعًا، ويجاهدون في سبيل الله جميعًا، وبهذا الأصل العظيم، الذي تحقق بين المؤمنين في مكة قبل هجرتهم للمدينة وإقامة الدولة فيها؛ حيث تساوى حمزة الهاشمي، وعمر القرشي، مع صهيب الرومي، وبلال الحبشي، واستطاع المسلمون أن يقيموا أول دولة، وأول مجتمع إنساني عرفهما العالم؛ تحققت فيهما الأخوّة الإنسانية، والأخوّة الإيمانية بين جميع أفراده، وما ترتب على ذلك من أحكام وتشريعات ألغت كل الفوارق التي كانت ترسخها النظم الجاهلية للتميز بين الناس بالعرق، أو الجنس، أو اللون، أو الطبقة؛ حتى قال النبي ﷺ لأبي بكر في شأن سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي حين أغلظوا القول لأبي سفيان بعد فتح مكة، فنهاهم أبو بكر؛ فقال له النبي ﷺ: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك»([158]).
وحتى قال ﷺ عن سلمان الفارسي: «سلمان منّا آل البيت»([159])، وحتى قال عمر: «أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا، يعني بلالًا»([160]).
فصار بلال الحبشي الذي كان عبدًا يضرب بالسياط في الجاهلية بمكة؛ سيدًا للمؤمنين في مدينة الإسلام والإنسانية، ومجتمع المساواة والحرية.
وفي الحديث: (كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي ﷺ في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر)([161]).
وكل ذلك يعد ثورة وانقلابًا في قيم المجتمع العربي وتحولًا جذريًا لا مثيل له في التاريخ الإنساني في مجتمع كان من أكثر المجتمعات طبقية وعنجهية وتمايزًا بين فئاته وأفراده بحسب الشرف والنسب والأصل والمكانة!
الأصول السياسية في سورة الشورى المكية:
لقد دعا النبي ﷺ وهو في مكة إلى الدين، وإلى (كلمة واحدة تدين لهم بها العرب)، والدين في لغة العرب يأتي بمعنى السلطة والطاعة والحكم والقضاء والسياسة ولا يتحقق شيء من ذلك إلا في ظل دولة وسلطة؛ وهذا ما أدركته قريش في بداية دعوة النبي ﷺ؛ إذ مضمونها دعوتهم إلى طاعته واتباعه؛ ليحكم بينهم بالعدل، ويسوسهم بالقسط؛ كما قال تعالى في سورة الشورى نفسها، وفيها جاء ما يلي:
﴿ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيم. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم....
وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ...
أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾([162]).
﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ....
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ...
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ...
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ...
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِير...
اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ...
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾([163]).
﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُون. وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِين. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾([164])
﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ....
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا...
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾([165]).
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات -مسبوكًا كلامه محذوفًا ما لا تعلق له في أصول الخطاب السياسي-"كذلك يوحي إليك الله العزيز في انتقامه، الحكيم في أقوله وأفعاله، له ما في السموات وما في الأرض الجميع عبيد له وملك له، تحت تصريفه وقهره، وهو العلي الكبير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة إما على الهداية أو على الضلالة، أم اتخذوا من دونه أولياء آلهة من دون الله، فالله هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، فمهما اختلفتم فيه من الأمور، وهذا عام في جميع الأشياء، فحكمه إلى الله، فهو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ﷺ، ذلكم الله ربي أي الحاكم في كل شيء، عليه توكلت وإليه أرجع في كل الأمور، فاطر السموات والأرض وخالقهما وما بينهما، ليس كمثله شيء الفرد الصمد الذي لا نظير له، له مقاليد السموات والأرض فهو الحاكم المتصرف فيهما، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا... أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي: وصى الله جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد، وإنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم، وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة، ولولا الكلمة السابقة من الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا، فلذلك فادع الناس إليه، واستقم كما أمرت أنت ومن تبعك على عبادة الله، ولا تتبع أهواءهم فيما اختلفوا فيه... وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم في الحكم كما أمرني الله، الله ربنا وربكم المعبود لا إله غيره، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم ولا خصومة، الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير والمرجع... الله الذي أنزل الكتاب بالحق على أنبيائه والميزان وهو العدل والإنصاف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من تحريم ما حرموا عليهم وتحليل الميتة والقمار ونحو ذلك، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم ...والذين استجابوا لربهم، فاتبعوا رسوله وأطاعوا أمره، واجتنبوا زجره... وأمرهم شورى بينهم، فلا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا، ومما رزقناهم ينفقون بالإحسان إلى الخلق...والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ممن ظلمهم واعتدى عليهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو ... ولمن انتصر بعد ظلمه فليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم... إنما السبيل والجناح والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق... استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا، ولست عليهم بمسيطر ...لله ملك السموات والأرض، خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما...) انتهى كلام ابن كثير مختصرًا مسبوكًا.
فهذه الآيات المكية من أوضح الأدلة على طبيعة الدعوة النبوية في مكة، وأنها ليست -كما يُشاع في الثقافة المعاصرة- قاصرة على الدعوة إلى ترك عبادة الأوثان فقط، وأن الصراع والجدل إنما كان يدور حول هذه القضية فقط -وهو اختزال خطير لموضوع الرسالة، ومقاصدها وغاياتها؛ أدى إلى هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم من ظلم، وتظالم، وتعطيل لحكم الله ورسوله-؛ بل كانت الرسالة السماوية المحمدية تشتمل؛ كما ورد في آيات الشورى على:
1- دعوة للتوحيد الديني بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأوثان والأنداد، والأولياء والأضداد.
2- ودعوة للتوحيد التشريعي بتوحيد الحاكمية لله، والتحاكم إليه وحده، وتحكيم كتابه ورسوله.
3- ودعوة للتوحيد السياسي والاجتماعي، بالاجتماع والوحدة، وعدم الافتراق في الدين، أو الطاعة والحكم.
4- ودعوة إلى الشورى في الأمر، والعدل في الحكم، والمساواة بين الخلق، وتقرير حق القصاص، وحق العفو، وحق الدفاع عن النفس، والانتصار والانتصاف ممن ظلم واعتدى، ورفض الظلم والعدوان بكل أشكاله وصوره.
إنها دعوة لقيام دولة، ونظام عقائدي، وسياسي، وتشريعي، واجتماعي؛ يختلف اختلافًا جذريًا وكليًا عما كانت عليه الجاهلية كلها، عربها، وأممها، من شرك واختلاف ديني وتشريعي -حيث كان لكل قبيلة أوثانها، وكهانها، وأديانها- وما كانت عليه الجاهلية من ظلم وتظالم، واختلاف طبقي وعصبي، وما كانت عليه من تشرذم وافتراق؛ فلا جماعة توحدهم، ولا سلطة تحكمهم، ولا دولة تنظم شئون حياتهم، وتحفظ لهم كيانهم، فجاء الإسلام دين التوحيد؛ ليوحدهم دينيًا، وسياسيًا، وتشريعيًا، واجتماعيًا، وليقيم لهم دين الحق، ودولة العدل، وميزان القسط، وليخرجهم من الظلمات إلى النور.
لقد تضمنت آيات سورة الشورى المكية، كل أصول الخطاب والنظام السياسي الإسلامي، الذي بشرت السورة بقرب قيامه في المجتمع الإيماني الذي كان يتشكل في مكة على أنقاض المجتمع الجاهلي، وقيمه ونظمه، وكانت الجماعة المؤمنة التي التفت حول النبي ﷺ هي نواته الأولى، وهي التي ستقيمه بعد ذلك في المدينة؛ وفق هذه الأصول التي وردت في الشورى؛ وهي:
أولًا: أن الملك لله وحده؛كما ورد في السورة: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم﴾، و﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾، و﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾، ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء﴾، فليس معه ملوك ولا سادة؛ بل له وحده الملك والسيادة، وله وحده حق التصرف المطلق في الملك الذي لا ينازعه فيه أحد؛ بما يشرع فيه من حكم، ويصرف فيه من قضاء وقدر، فقرر سبحانه في هذه الآيات من سورة الشورى:
أ- توحيده في الخلق: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾([166])، وتوحيده في الملك: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾([167]).
ب- وتوحيده في الربوبية، والسيادة في التصريف والتدبير: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾([168])، فهو سبحانه العزيز الحكيم، والعلي العظيم؛ فهذه صفاته التي استحقها ووجبت له، فلا عظيم غيره، ولا عزيز معه، ولا علي سواه، وهي الصفات التي يزعم ملوك الأرض وطغاتهم أن لهم فيها نصيبًا؛ يوجب لهم على الناس حق الخضوع والطاعة ظلمًا وعدوانًا.
ثانيًا: وأن الأمر لله وحده﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾([169])الذي له على خلقه الولاية المطلقة، وليس معه ولي غيره، ولا لعباده ولي من دونه، والولي في لغة العرب تطلق على المالك للشيء، وعلى من له حق التصرف فيه، ومن له لقدرة على الفعل والعمل لتدبير الأمر، والولاية السلطة والسلطان -كما قال ابن السكيت- والولي الذي له السلطان والولاية، وكل هذه المعاني واجبة لله جل جلاله، والإتيان بضمير الفصل (هو)، بين المبتدأ (الله)، والخبر (الولي)، يفيد الحصر والقصر، فالله وحده هو الولي، وليس للخلق ولي للأمر سواه، وجاء بأل التعريف في (الولي)، إفادة للاستغراق والشمول والإطلاق، وإنما استحق هذه الولاية المطلقة؛ لكونه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي على كل شيء قدير ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾([170])، وإنما ينازعه في ذلك ملوك الأرض وطغاتهم كما قال النمرود: (أنا أحيي وأميت)!.
ثالثًا: وأن لله وحده الحكم والتشريع، والتحليل والتحريم؛ فهو الذي يشرع لعباده، ويفصل بينهم بحكمه ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾([171]) فله وحده حق التشريع المطلق للخلق، وعلل استحقاقه للحكم بقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾([172]) وبقوله: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾([173])فهو الرب والسيد الذي له حق الأمر والزجر؛ بل كل من اتخذ غيره مشرعًا له فقد أشرك به ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾([174])، فليس للملوك حق معه لا في الملك، ولا في التصرف، ولا في التشريع؛ كما في الأنظمة الاستبدادية، ولا لرجال الدين؛ كما في الأنظمة الثيوقراطية، ولا للشعب ولا للأغلبية أن تشرع للأقلية ما تشاء؛ كما تقرر الأنظمة الديمقراطية، ولا للطبقة العمالية الكادحة أن تشرع ما تشاء مما قد يضر بأصحاب الأموال؛ كما يجري في الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، ولا للرأسمالية أن تشرع للمجتمع ما تريد مما يتوافق مع أهوائها وما تقتضيه مصالحها ولو على حساب الفقراء، ولا يحق لمخلوق أن يشرع التشريع المطلق لمخلوق مثله؛ سواء كان مؤمنًا أو غير مؤمن، إذا لا حق ولا امتياز لبشر فيه على بشر، ولا ضمان في هذه الحال من حدوث الظلم والجور والعدوان عند وضع القوانين؛ بل ولا ضمان ألا تستبد الأكثرية، وتشرع ما يوافق مصالحها ضد الأقلية، فالإنسان كما وصفه القرآن كان ﴿ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ([175])؛ بل المرجعية في الحكم هي الله وحده؛ كما قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾([176])، فهو سبحانه الذي يقسم الحقوق، ويحدد الحدود؛ كما جاء في الحديث: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء»([177])، وفي الحديث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»([178]).
رابعًا: وأن الله أوجب الجماعة والوحدة والائتلاف، وحرم الفرقة والتشرذم والاختلاف ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾([179])، والدين بمفهومه العام يشمل العبادة، والطاعة، والسلطة؛ كما في قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾([180])، أي: لا إكراه في العبادة والطاعة، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾([181])، أي: سلطان الملك وحكمه، فدعت سورة الشورى الناس كافة إلى اتباع النبي ﷺ وطاعته، والتحاكم إليه، وأن يقيموا الدين - بمفهومه الشمولي- ولا يتفرقوا فيه؛ فهي دعوة إلى التوحيد الديني في العبادة والطاعة لله، واتباع رسوله، والتوحيد السياسي في الحكم والسلطة، وعدم الاختلاف والافتراق عن الدين أو عن النبي ﷺ وطاعته وسلطته.
ومما يؤكد الترابط بين الأصلين التوحيد والوحدة حديث الصحيحين: «إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
خامسًا: وأن الحاكم بينهم في الأرض هو النبي ﷺ، بإذن الله وأمره، فهو المأمور بذلك ﴿وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾([182]).
سادسًا: وأن قوام الحكم هو العدل بين الجميع؛ المؤمنين ومن خالفهم من غير المؤمنين ﴿وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾([183])، وأن القضاء والفصل بينهم هو بالكتاب، أي: القرآن وهو العلم والنور والحق، والميزان وهو العدل والإنصاف والقسط، ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾([184])، فليس للنبي أن يحكم وفق هواه، ولا وفق أهوائهم، ﴿وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾([185])، ولا يداهنهم في الحق، ولا يميل معهم، من أجل إرضاء الملأ على حساب الضعفاء، والفقراء، والعبيد.
سابعًا: وأن الأمر شورى بينهم في كل أمورهم ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾([186])، فالإمارة بعد النبي ﷺ شورى بينهم، فهم الذين يختارون خليفتهم برضاهم وشوراهم، فلا ملوك، ولا وراثة، ولا قهر، ولا مغالبة، فالأمة مصدر السلطة، وهي من تختار الإمام، كما أن الأمر شورى في كل أمر من أمور حياتهم، مما لا نص فيه؛ إذ أن حق التشريع المطلق لله وحده، أما الأمة؛ فلها حق التشريع المقيد؛ كالشورى في اختيار السلطة، وفي التشريع فيما لا تشريع فيه، و فيما فيه تشريع يحتاج في تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع إلى اجتهاد وشورى، وفي كل شأن دنيوي يباح لها تنظيمه، فالله هو الذي جعل الأمر للمؤمنين، وهو الذي شرع لهم ذلك، إذ هو الملك، وهم في عدم الملك سواء، ليس فيهم من له شرك في ملك الله؛ ولهذا كانت الشورى هي الحكم العدل، الموافق لتوحيد الله في الملك، والحكم، والسيادة، وكل حكم يخالف الشورى، وحق الأمة فيها، فهو جاهلية، وكسروية، ومحادة لله في أخص خصائصه وأحق حقوقه، واستعباد لعباده من دونه، ومنازعته في طاعتهم.
ثامنًا: وأن الزكاة فرض، والتكافل الاجتماعي حق، لكل فرد من أفراد المجتمع الجديد ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون﴾([187])، فللفقراء، والمساكين، والضعفاء؛ حق معلوم، يؤخذ من الأغنياء، ويدفع للفقراء.
تاسعًا: وأن رد الظلم، ودفع العدوان عن النفس والمال والعرض حق، وأن البغي محرم كله بجميع صوره وأشكاله ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُون﴾([188])؛ سواء كان البغي والعدوان من الأفراد أو السلطة.
عاشرًا: وأن القصاص حق وعدل لمن وقع عليه ظلم واعتداء، فله القصاص والعدل، أو العفو والفضل؛ بلا ظلم في القصاص، ولا تجاوز في الاقتصاص ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾([189]).
الحادي عشر: وأنه لا سبيل ولا جناح على من انتصر لنفسه، ودفع الظلم عنها ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل﴾([190]). بل السبيل على من يظلمون الناس، ويفسدون في الأرض بغير الحق ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾([191])، فللناس حق الدفاع عن أنفسهم، ورد الظلم عنهم، وللأمة حق التصدي لمن أراد ذلك منها أو بها، فقد أذن الله لها به؛ بل جعل ذلك من أبرز صفات المجتمع الإيماني الإسلامي الذي سيقوم على أنقاض المجتمع الجاهلي، الذي يقبل الظلم والتظالم، فالظلم محظور بكل صوره، على المؤمن وغير المؤمن، والفساد في الأرض محرم كله. بل المطلوب والمقصود من إقامة الدين والدولة، والجماعة، والسلطة، نشر العدل، وتحقيق الإصلاح.
الثاني عشر: وأن التعددية الدينية، والحرية العقائدية؛ أصل من أصول الخطاب القرآني، فكل ما سبق تقريره ما سبق تقريره؛ لا يصادر حق الإنسان في البقاء على دينه؛ ولهذا قال في آيات الشورى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل﴾([192])، فالله وحده هو الوكيل الذي يحاسبهم يوم القيامة، ولست عليهم بحفيظ، ولا مسئولا عنهم، وقال أيضا في سورة الشورى: ﴿وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾([193])، إلا أنه سبحانه خلقهم ليبتليهم، ويختبرهم، ولا يتحقق ذلك بإجبارهم؛ بل بتحريرهم وجعلهم أحرارًا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ ليقيم عليهم حجته، ﴿وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾([194])؛ فالمطلوب أن تحكم بينهم في الدنيا بالعدل، ولله يوم القيامة الحكم بينهم والفصل، وإنما عليك دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله واتباعه ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾([195])، ولست عليهم بمسيطر؛ إذ الحكمة الربانية تقتضي أن يكونوا أحرارًا ليعبدوه ويطيعوه برضا واختيار، بلا إكراه أو إجبار؛ ليتحقق الابتلاء والاختبار فـ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾([196])، فالتعددية الدينية، والحرية العقائدية؛ مقصودة لله العليم الحكيم؛ كما قال تعالى في سورة هود وهي مكية: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين. إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾([197])، قال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا يزال الاختلاف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، ولذلك خلقهم... قال الحسن البصري: وللاختلاف خلقهم)، مع أنه لو شاء سبحانه لجعلهم أمة واحدة، وجماعة واحدة، وعلى ملة واحدة، إلا أنه سبحانه أراد منهم -إرادة كونية قدرية لا إرادة حكمية شرعية- غير ذلك، فقد أراد ابتلاءهم واختبارهم، وجعل الحكم في هذا الاختلاف بينهم له يوم القيامة، أما في الدنيا فقد أمرهم بالعدل والقسط، وأن يكونوا أحرارًا، ليس أحد عليهم بمسيطر؛ كما تقرر بعد ذلك في المدينة، حيث نزل قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾([198])، مؤكدًا هذا الأصل الذي تقرر في الخطاب المكي.
فتجلى -في هذه السورة وحدها من سور العهد المكي- الخطاب السياسي القرآني، وأصوله كلها التي أمر الله رسوله بالدعوة إليها في سورة الشورى نفسها في قوله تعالى له: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾([199])أي: ادع إلى كل ما جاء في هذه السورة من أصول وأحكام وتشريعات، هذه الأصول التي عالجت كل إشكالية عقائدية وسياسية وتشريعية ضرورية لقيام الدولة والمجتمع في النظام الإسلامي، تلك الأصول التي تقوم على أساس أن الملك لله وحده، والسيادة له وحده، وعلى ضرورة وجود الدولة بالجماعة والاجتماع، وعدم الافتراق والاختلاف، وضرورة قيام السلطة التي يتحاكمون إليها، وتحكم بينهم بالعدل، وتحديد المرجعية في الحكم والتشريع وهو كتاب الله، وما جاء به رسوله ﷺ، وتحديد المرجعية في اختيار السلطة وهي الأمة، التي تمارس حقها في الأمر الذي جعله الله لها بالشورى، وتحديد الغاية من ذلك وهو تحقيق العدل، ورفع الظلم، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتنظيم دورة المال؛ كي لا يكون دولة بين الأغنياء، وذلك بفرض الزكاة، ووجوب الإنفاق على الفقراء، وتحقيق الضمان الاجتماعي لهم، وأن يقوم كل ما سبق على أساس من التعددية الدينية والحرية السياسية، للمؤمن وغير المؤمن، ما دام تحت حكم الله ورسوله.
إن كل ما سبق بيانه من أصول عقائدية، وقضايا إيمانية، في الخطاب القرآني المكي، التي تحدد العلاقة بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين الإنسان ومجتمعه؛ هي الأساس الذي يقوم عليه الخطاب السياسي الإسلامي، والذي سيتجلى على أرض الواقع بالخطاب النبوي في المدينة النبوية، ثم بعد ذلك بالخطاب الراشدي، الذي استطاع أن يحكم دولة كبرى تمتد من أقصى حدود أفغانستان شرقًا، إلى أقصى حدود تونس غربًا، ويرث الإمبراطورية الفارسية كلها، وأقاليم الإمبراطورية الرومانية في أسيا وأفريقيا كلها، على أسس من العدل، والحرية، والمساواة، والرحمة، والتعددية والتسامح الديني، بما لا عهد للأمم به من قبل، ولا من بعد، وهو ما يجعل من البحث في أصول هذا الخطاب أمرًا ضروريًا؛ لأنها الأساس الذي جاءت كل أحكام الشريعة للتعبير عن مضامينه ومقاصده وغاياته، وهي الأصول المحكمات للخطاب السياسي التي ترد إليها المتشابهات والمشكلات؛ لفهم وتفسير كل الأحداث السياسية في العهد النبوي والراشدي، فلا يمكن فهم الخطاب السياسي الإسلامي إلا بعد فهم الخطاب العقائدي الإيماني القرآني والنبوي، وهو أن الملك لله وحده، والطاعة له وحده؛ كما أبان عن ذلك ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِير﴾([200])حيث قال: "أخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهما، فإن الخلق أهل مملكته وطاعته، عليهم السمع له والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما شاء، ونهيهم عما شاء، ونسخ ما شاء، وإقرار ما شاء، وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه، ثم قال لنبيه ﷺ وللمؤمنين معه: انقادوا لأمري، وانتهوا إلى طاعتي، فيما أنسخ وفيما أترك من أحكامي، وحدودي، وفرائضي، فإنه لا قيم بأمركم سواي، ولا ناصر لكم غيري، وأنا المنفرد بولايتكم، والدفاع عنكم، والولي معناه فعيل من قول القائل: وليت أمر فلان إذا صرت قيمًا به فأنا أليه فهو وليه وقيمه"([201]).
فليس للخلق ملك إلا الله، ولا ولي له عليهم الولاية والسمع والطاعة إلا الله، وأن ولاية من سواه تبع لولايته وسلطته، فمن جعل له دون الله وليًا دون الله يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه؛ فقد أشرك بالله في ملكه وطاعته وولايته.
وهذا الأصل العظيم من أصول التوحيد هو الذي ستأتي كافة التشريعات والأحكام السياسية العملية لتعبر عنه أوضح تعبير؛ كما سيتجلى في الخطاب النبوي والراشدي.
([85]) كما في حديث: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضًا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة)
([91]) كما في حديث النبي ﷺ في خطبة أيام التشريق: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا: بلغ ﷺ)
([99]) انظر قول ابن قدامة الحنبلي في الكافي 4/48 (الأصل الحرية والظاهر في الدار ـ أي دار الإسلام ـ الحرية)، وفي الشرح الكبير للمقدسي 9/480 (الأصل الحرية والرق طارئ).
([104]) رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر 167 بإسناده عن ثابت وحميد الطويل عن أنس أن عمر، وهذا إسناد صحيح.
([159]) رواه الطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/130(فيه كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه).
[164])) الشورى 38-42











الرسالة الرابعة (الأصول الإيمانية القرآنية للسياسية الشرعية)