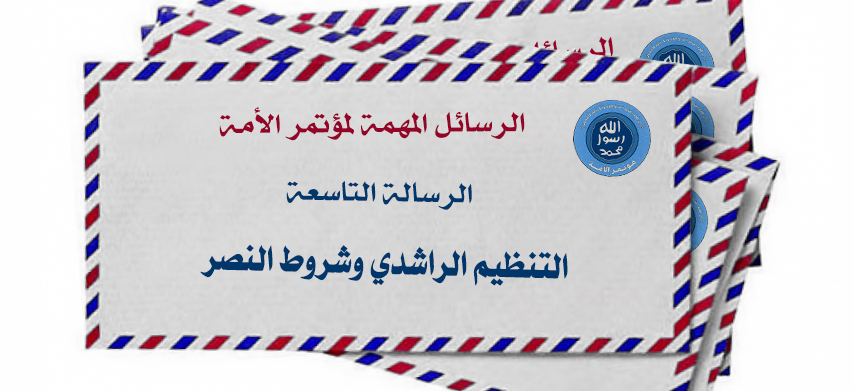
الرسالة التاسعة (التنظيم الراشدي وشروط النصر)
- بواسطة مؤتمر الأمة --
- الخميس 15 جمادى الثانية 1434 00:00 --
- 0 تعليقات
الرسالة التاسعة
(التنظيم
الراشدي وشروط النصر)([1])
إذا كان من شرط استعادة الخلافة الراشدة قيام حكومات راشدة، تحمل على عاتقها تحقيق هذا المهمة التاريخية على مستوى الأمة، فإن إقامة حكومات راشدة في كل قطر يشترط أن يسبقه وجود تنظيمات سياسية راشدة، تسعى لتحقيق هذه المهمة في كل بلد إسلامي، وهو ما يقتضي أن يتنادى المصلحون الراشدون إليها، وأن يتداعوا عليها، ليكملوا النقص، ويسدوا الخلل، ويتداركوا ما فات الحركات الإصلاحية الأخرى، على أساس التكامل والتعاون معها في تحقيق مشروع نهضة الأمة.
وهنا لا بد أن يتوفر لهذه التنظيمات السياسية الراشدة شروط ومواصفات في قياداتها وأنصارها وأحزابها ومشروعها السياسي؛ لتحقيق النصر المنشود.
وقد وصف القرآن الجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم بالرشد، فقال تعالى عنهم: {ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون}، وجعل الرشد غاية الإيمان وثمرة الاستجابة؛ فقال تعالى: {فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون}، وأمر النبي ﷺ من جاء بعدهم بلزوم هديهم ليرشدوا مثلهم؛ فقال كما في الحديث الصحيح: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)، وقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)!
فكان الرشد أشرف صفات أهل الإيمان، وهو غاية طاعتهم وعبادتهم واستجابتهم لله ولرسوله، وذلك بأن يتحقق لهم الرشد وهو الاهتداء والاستقامة، وبلوغهم درجة الكمال روحا وعقلا، وصلاح أحوالهم قولا وفعلا؛ فلا يتحرون إلا الحق، ولا يفعلون إلا الصواب، ولا يريدون إلا الخير، ولا يحبون إلا العدل.
ولهذا كان على الجيل الراشدي الجديد الذي يحمل على عاتقه مهمة إعادتها من جديد (أمة واحدة وخلافة راشدة)، أن يترسم خطاهم فيما هو بسبيله؛ إذ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا معنى الاقتداء بهم؛ كما في الحديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)؛ فالاقتداء يشمل حتى التشبه بهم وبأحوالهم وأفعالهم وهديهم؛ وهو أعمّ من اتباع سننهم!
إن معرفة ذلك كله، ومعرفة أسباب النصر وشروطه التي تحقق لهم بها التمكين والاستخلاف في الأرض؛ كل ذلك شرط لتحقق النصر للراشدين والمصلحين الجدد، فقد أخبر النبي ﷺ عن غربة ثانية، وعودة للإسلام ثانية؛ فقال: (بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس)!
وهناك شروط وصفات يجب أن تتوفر لقيادات العمل الراشدي اليوم؛ لتكون أهلا للنصر، كما يجب أن تتوفر في أنصارهم وأشياعهم صفات الرشد التي تجعلهم أهلا للقيام بالمهمة:
أولا:صفات القيادة الراشدة:
وليس المقصود هنا الصفات العامة التي تحققت في أهل الإيمان كما فصل فيها القرآن كالإيمان والتقوى والصلاح، وإنما المراد الصفات الخاصة التي توفرت في الخلفاء الراشدين قبل أن يصبحوا خلفاء، والتي أهّلتهم للاستخلاف في الأرض، تلك الصفات التي تحلّوا بها قبل أن يكونوا خلفاء، والتي اشتهروا بها منذ آمنوا وأسلموا؛ إذ كانوا جميعا قادة الدعوة مع النبي ﷺ في مكة، إلى أن أقاموا الدولة في المدينة، ثم أقاموا الخلافة بعد وفاته ﷺ، ومن ينظر في أبرز صفات الخلفاء الراشدين يجدها تتمثل في:
1- صديقية أبي بكر وعقائديته التي لا يطرأ عليها شك، ولا يخالطها ريب، ولا يعيقها تردد، وهو إيمانه المطلق بأن الله حق، والرسول حق، وأن ما جاء عنهما هو الحق، ووعدهما الحق، وهي الصفة التي شهرت أبا بكر حتى لقب بالصديق، كما وصفه القرآن {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون}، ومنزلة الصديقية هي التالية لمنزلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين؛ كما قال تعالى: {مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين}.
لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته؛ فكان أول من آمن بالنبي ﷺ من الرجال، وأول من صدّق حادثة الإسراء والمعراج، حين كذب بها من كذب، وشك من شك، حتى إذا هرعت قريش لأبي بكر تسأله؛ فإذا جوابه جواب الصديقين: (ويحكم أنا أصدق محمدا بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء، فكيف لا أصدقه بالإسراء)!
إنه الإيمان المطلق بالغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث، وعما يستقبل منها كأنه يراها رأي العين!
لقد ضعفت عرى الإيمان لدى كثير من المسلمين ودعاتهم وعلمائهم اليوم حتى أصبح بعضهم على (دين بلا يقين) فهم في شك من دينهم، وفي شك من كمال شريعتهم، وفي شك من سنن النبي ﷺ وخلفائه في سياسة الأمة، وفي شك من وجوب اتباعها، وفي شك من صلاحيتها لعصرهم، وفي شك من بطلان هذه الجاهلية التي تحكمهم وتسوس شئونهم، وفي شك من وعد الله لهم بالنصر إن هم نصروه، وفي شك من عودتها خلافة راشدة كما أخبر بذلك ﷺ، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله!
ففقدوا بهذه الشكوك المتراكمة - التي ثبطتهم عن القيام لله بالقسط والحق - درجة الصديقية!
لقد تجلى إيمان أبي بكر العميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى؛ وكان أولها حين دخل على النبي ﷺ بعد وفاته وهو على سريره، فقبله وقال: (طبت حيا وميتا يا رسول الله! أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تموت بعدها أبدا)، وخرج على الناس وهم في المسجد وقد أصابهم هول المصيبة حتى طاشت عقولهم، وعمر يهذي ويقول: والله ما مات رسول الله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى!
فجاء أبو بكر يمشي حتى وقف في المكان الذي حق له الوقوف به وخطب الناس بكلماته الخالدة (أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم})!
لقد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين، فثاب المسلمون إلى رشدهم، وأدركوا أن الواجب عليهم في هذه اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول الله ﷺ بعد وفاته كنصره في حياته، وذلك بنصر دينه، وحمل رسالته، وحماية دولته، وإكمال مهمته؛ فبادروا إلى السقيفة في اليوم ذاته ليتشاوروا في أمر الخلافة واختيار السلطة، ومن يسوس شئون الأمة بعد رسول الله ﷺ، فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، اختلفوا واضطربوا حتى كادوا أن يقتتلوا، فإذا الصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمر على الأمة وفي أشد أيامها، فانبرى لهم أبو بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنصار: (أما ما ذكرتم من فضل فأنتم له أهل، إلا أن العرب لا ترضى إلا بهذا الحي من قريش، فاختاروا أي الرجلين ترون عمر أو أبا عبيدة بن الجراح)؟
فقالوا: بل أنت يا أبا بكر! فتتابع المهاجرون ثم الأنصار على بيعته، كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى كادوا أن يتفرقوا!
ثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية؛ ليبين لهم سنن الإمامة والخلافة الراشدة: (أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم)!
ثم كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضية أهل الردة، فقد اضطرب الصحابة في حكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعوا أداء الزكاة للدولة والخليفة بعد رسول الله، حتى قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله!
فقال أبو بكر: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه)!
فما كان من الفاروق وهو الفاروق إلا أن قال: (والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا القول حتى عرفت أنه الحق)!
إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر، بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بنص القرآن وبشهادة رسول الله له، وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر، فكان عمر مع رفضه لقتال مانعي الزكاة ومجادلته أبا بكر فيهم، أول من رجع عن رأيه لرأي أبي بكر، حتى أجمع الصحابة على قتالهم، حتى قال ابن مسعود: لقد كدنا نهلك بعد رسول الله ﷺ، حين ارتدت العرب، قلنا نعبد الله ولا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون، حتى هدانا الله بأبي بكر، فقال والله لأقاتلنهم، فوالله ما قبل منهم إلا الحرب المجلية، أو الخطة المخزية!
فلما جاء المرتدون تائبين؛ أبى أبو بكر حتى يشهدوا على أن قتلاهم في النار، وقتلى الصحابة في الجنة!
لقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك وريب، ولا أن يخالط الإيمان شبهة رأي، فأراد منهم قبل كل شيء، وقبل أن يعودوا إلى صفوف المؤمنين، أن يجددوا إيمانهم بالله ورسوله وبدينه، حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام، ولا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يزعم زاعم أنه قاتلهم اجتهادا!
ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأولى من وفاة النبي ﷺ، والتي واجهها أبو بكر بإيمان وطمأنينة، إنفاذ جيش أسامة بن زيد، وكان النبي ﷺ قد أمر الجيش بالاستعداد للتوجه للشام، فتوفي ﷺ قبل أن يخرج الجيش، فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يؤجل خروج الجيش، حتى يحمي المدينة من أهل الردة الذين يحاصرونها، فما كان من الصديق إلا أن وقف الموقف الذي يقتضيه مقام الصديقية؛ فقال: (والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، حتى لو تخطفتنا الطير)، وأمضى الجيش إلى وجهته للشام، وترك المدينة بلا حماية، إيمانا منه بأن أمر رسول الله نافذ على الجميع في حياته وبعد موته ﷺ، وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق والهداية {وإن تطيعوه تهتدوا}!
فكانت طاعته لرسول الله ﷺ بعد وفاته، كما هي في حياته، إنها تسليم مطلق، وانقياد تام، فهو النبي والإمام والقائد العام، حيا وميتا ﷺ!
ثم كان الموقف التاريخي الآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام، بعد حرب داخلية استمرت سنة كاملة، جيّش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الردة وأهلها، وأخذ يشاور الصحابة في جهاد هرقل الروم أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ، وكان كلا الفريقين يتربص بالمسلمين ودولتهم الفتية الدوائر، فقال بعضهم دع الناس حتى يستجموا ويستعيدوا عافيتهم بعد حروب الردة، وقال آخرون بل نبدأ بالفرس، وقال بعضهم بل نبدأ بالروم، فأجابهم أبو بكر بكل ثقة بالله ووعده ونصره (بل نبدأ بالطائفتين معا) استجابة للأمر الإلهي {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة}!
ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنساني إلى اليوم، وليتحقق موعود الله لعباده المؤمنين الراشدين {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض..}!
فبدأ أبو بكر مهمة الفتح التاريخي، ورحل بعد سنتين من استخلافه؛ ليصنع في تينك السنتين تاريخ الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلها، فإذا كل الملايين من المسلمين على اختلاف قومياتهم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هم من حسنات أبي بكر وفي ميزان أعماله يوم القيامة، كما جاء في الحديث (وزنت في كفة والأمة في كفة فرجحت، ووزن أبو بكر في كفة والأمة في كفة ولم أكن فيها، فرجح أبو بكر)، كل ذلك بسبب صديقيته وإيمانه ويقينه، حتى قال عنه بكر بن عبد الله المزني: ما فضلهم أبو بكر الصديق ولا سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، بل بشيء وقر في قلبه!
2- العبقرية العمرية التي اشتهر بها الفاروق عمر؛ كما وصفه النبي ﷺ في الصحيح: (فلم أر عبقريا يفري فريه)، والإلهام والتحديث؛ كما قال عنه النبي ﷺ: (كان فيما مضى محدثون فإن يكن في أمتي فعمر)!
فإذا كانت إقامة الخلافة، ومواجهة الردة بعد وفاة النبي ﷺ، وبدء الفتوحات، مواقف تاريخية تحتاج إلى قائد عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر الصديق؛ فإن اتساع دولة الإسلام لتضم إمبراطورية كسرى في الشرق، وقيصر في الغرب، وما كانتا عليه من حضارة ونظم، وما تعانيه شعوبهما من قهر وظلم، تحتاج إلى قائد عبقري فذ كعمر رضي الله عنه؛ ليسوس شئونها بكل ذكاء وحنكة وكفاءة، ليبسط الأمن ويحقق العدل للجميع، فكانت نتيجة تلك العبقرية فهم غايات ومقاصد الإسلام في إقامة الأحكام، فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن تقسم على الفاتحين، وجعلها وقفا على الدولة والأمة كلها؛ ليمنع أن تكون الأموال والأرض {دولة بين الأغنياء}، ودوّن الدواوين واستفادها من فارس والروم؛ عملا بحديث: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، وحين رفض نصارى تغلب أن يدفعوا الجزية، وقالوا: نحن عرب ندفع كما يدفع العرب، قال: افرضوا عليهم الصدقة. وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين، من المسلمين وغير المسلمين، وأن يفرض للأطفال الرضع وأمهاتهم ما يغنيهم، وسن للأمة سنن الهدى في باب سياسة الأمة، حتى ضرب به المثل في العدل، كل ذلك بذكاء وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسة الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى؛ فكان عمر إمام الراشدين في هذا الباب!
3-القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها؛ والتي تجلت في أوضح صورها بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان منذ أن آمن وهو يحوط الدعوة بماله ونفسه وأهله، فهاجر الهجرتين، وبذل ماله في سبيل الله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنفاق، حتى اشترى الجنة بماله مرتين، حين اشترى بئر رومة وأوقفها على المسلمين، بعد أن سمع النبي ﷺ يقول من يشتريها وله الجنة، وحين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي ﷺ، وبلغ عدده نحو أربعين ألفا، وكان المسلمون في حال عسرة وحاجة وشدة؛ فجاء بالأموال فصبها بين يدي رسول الله صبا طاعة لله ولرسوله ونصرة لدينه، حتى قال رسول الله: (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم! ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم!).
كما اشتهر عثمان بالحياء، فكان أشد حياء من البكر في خدرها، وبلغ من حيائه أن النبي ﷺ كان يستحي منه ويقول (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)!
فجمع هذا القديس الطاهر بين السخاء والحياء؛ كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفك عن صفة السخاء والحياء، حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسفك بسببه قطرة دم، فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاته تجاوزاتهم، ورفض أن يضربهم أو يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه، فلما رجعوا وحاصروه أقسم على كل من كان يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه، ولزم داره يقرأ القرآن الذي حفظه صدرا وسطرا؛ حتى قتل شهيدا، وهو خليفة المسلمين الذي كانت جيوشه قد وصلت أطراف الهند، وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على مخالفيه ومعارضيه، إلا أن قديسيته وسخاء نفسه وخلقه وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليه إلا أن يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه!
4- الفدائية والطهورية؛ وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان فدائي الإسلام الأول، حين نام في فراش النبي ﷺ ليلة الهجرة، وقد أحاط المشركون بالدار، وقد عزموا على قتل النبي ﷺ على فراشه، وحين خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس العرب، حين دعا رسول الله لمبارزته فخرج له الليث الغالب وقد باع نفسه لله ولرسوله، وحين حمل الراية يوم خيبر وهو مريض يوعك طاعة لله ورسوله، فلا يدعوه رسول الله ﷺ لنائبة إلا أتاه، ولا لملحمة إلا كفاه، فكان الجندي الفدائي، حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئونها؛ فإذا الطهورية تتجلى في أبهى صورها فإذا هو الخليفة الزاهد العادل الذي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بين الناس بالسوية، ورفض أن يداهن أحدا على شيء في أمور الإمامة والسلطة وكان أحوج ما يكون إلى تأليفهم، فحملته طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حساب سلطانه ونفوذ أمره وطاعته!
لقد كانت هذه الصفات توفرت في الخلفاء الأربعة جميعا، إلا أن كل واحد منهم كان أشهر ببعضها من بعض، كما كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من قيادة الدعوة في مكة، ومن قيادة الدولة في المدينة، ومن العشرة المبشرين، قد اشتهر بصفة الأمانة حتى قال فيه النبي ﷺ حين أراد أن يبعثه إلى اليمن (أمين هذه الأمة أبو عبيدة)!
إن هذه الصفات التي اشتهر بها الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة رضي الله عنهم - العقائدية والعبقرية والقديسية والفدائية والطهورية والأمانة - هي أهم صفات القيادة الراشدة الجديدة، فإذا اجتمع للقيادات الراشدة :
1- إيمان القلوب وصفاؤها.
2- وعبقرية العقول وذكاؤها.
3- وطهورية الأرواح وزكاؤها.
4- وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها.
فقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النجاح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرض!
فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيادات راشدة، تجمع بين العلم والفهم، والحلم والحزم، والأمانة والزهد، حتى إذا ما مكّن الله لها في الأرض كانت رحمة للعالمين؛ تنصر الحق، وترحم الخلق، وتسوسهم بإيمان أبي بكر وصديقيته، وكفاءة عمر وعبقريته، ورحمة عثمان وقديسيته، وزهادة علي وطهوريته، وصيانة أبي عبيدة وأمانته!
إن الأمة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف عن أموالها، وتكف عن دمائها، وتلم شعثها، وتوحد كلمتها، وتحسن سياستها، وتحررها من عبوديتها، بعد أن أترعت الدماء على أيدي الطغاة، وأهدرت الأموال، وانتهكت الأعراض، وامتلأت السجون بالمظلومين، ببغي المجرمين، فإذا كانت قيادات الحركات السياسية الإصلاحية لم تعد نفسها إعدادا روحيا وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح، فإن تأخر النصر خير لها وللأمة من فجر كاذب، وبرق خلب!
ثانيا: صفات الأعضاء والأنصار:
فكما للقيادة الراشدة صفاتها التي يجب أن تتمتع بها، ولو بالحد الأدنى منها، فإن للأنصار وأعضاء التنظيم الإصلاحي الراشدي صفاتهم التي يجب أن يتصفوا بها؛ ليكونوا أهلا للنصر؛، ومن أهمها:
1- الإيمان بالله علما وعملا؛ كما قال تعالى: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين}، وكما قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون..}، والفلاح هو الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، والمراد بالإيمان هو الإيمان الذي يورث العمل الصالح {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين}، ويدخل في الصالحات القيام بالواجبات والمندوبات، وترك المحرمات...إلخ.
وقد جعل الله الإيمان به، واليقين بآياته ووعده، والصبر عليه؛ سببا من أسباب الاستخلاف في الأرض؛ فقال {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون}.
2- الاستقامة على الحق والإصلاح في الأرض، والصبر عليه، وتجنب الطغيان، وعدم الركون للظالمين، أو الميل للمجرمين والمترفين، وقد أوصى النبي ﷺ بالإيمان والاستقامة على الحق؛ فقال لمن استوصاه – كما في صحيح مسلم - (قل آمنت بالله ثم استقم)، وكما قال تعالى: {فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.. ثم لا تنصرون.. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.. فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون}.
فأمر الله نبيه والمؤمنين معه بالاستقامة ولزوم سبيل الرشاد والإصلاح في الأرض، والثبات والصبر عليه مهما لقوا من الشدة، وحذرهم من الطغيان وتجاوز العدل والقسط، ونهاهم عن الركون للذين ظلموا، إذ هو من أعظم موانع النصر والفلاح في الدنيا والآخرة {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ..ثم لا تنصرون}، وأمرهم في مقابل ذلك بالإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض؛ إذ هو سبيل النجاة، وهو خلاف سبيل الذين ظلموا، وخلاف سبيل الذين يركنون إليهم، وخلاف سبيل المترفين منهم، وخلاف سبيل المجرمين!
فمتى ركن المؤمنون أو مالوا للظالمين أو المترفين أو المجرمين؛ فقد أصابهم شؤم الظلم والترف والإجرام، فحرموا النصر والفلاح؛ إذ للمظلومين من ضحايا الملأ المجرمين دعوات تضج بها السماء، قد وعدها الله بالانتقام والعقوبة ممن ظلمها وأجرم بحقها، فإذا نزلت إلى الأرض سهامها أصابت الظالمين وكل من ركن إليهم {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا}، وأول ما يصيب الصالحين من شؤم الركون إلى الظالمين مخالطتهم لهم، فيهون في نظرهم ما هم فيه أو عليه من الفساد أو الطغيان أو الترف؛ فيطمس الله على قلوبهم، فتستحسن القبيح، وتستقبح الحسن، وتشمئز ممن يأمرهم بمعروف، أو ينهاهم عن منكر!
ولهذا كان الإصلاح والاستقامة تتنافى مع الظلم والإفساد في الأرض {إن الله لا يصلح عمل المفسدين}، وقال موسى لهارون: {اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين}، {ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون}.
فالاستقامة هي السير على الهدى، والثبات على الحق، والصبر عليه، وعدم الطغيان في حال القوة، وعدم تجاوز العدل والقسط، وعدم الميل عنه أو الركون للظالمين في حال الضعف، مهما اشتدت الملمات، أو تراكمت المدلهمات، أو تعاظمت الشهوات، فإن المصلحين يرضيهم في هذه الحياة أن تتحقق لهم السعادة والحياة الطيبة التي يجدونها بالإيمان وصلاح نفوسهم ورضاهم عن ذواتهم، {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} في الدنيا والآخرة، والحياة الطيبة الراضية هو ما يجده الصالحون من رضا نفوسهم، وسعادة أرواحهم، وطيب عيشهم، وهذا يغنيهم عن متاع الدنيا وغرورها، وأكدارها وأوزارها!
وقد أخبر النبي ﷺ عن حقيقة الغنى فقال - كما في الصحيحين - (ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس).
فإذا استغنت النفوس بما كتب الله لها من الدنيا عظمت همتها، وشرفت غايتها، وعرفت حقيقة وجودها، وغاية انتهائها، وأقبلت على معالي الأمور وتركت سفاسفها، كما في الحديث - عند الطبراني والحاكم وصححه -(إن الله جود يحب الجود، ويحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفاسفها)، وإنما يصنع المجد من يبذل المال لا من يجمعه، ومن يركب الخطر لا من يحاذره!
وكما قال الشاعر:
ومن ينفق الأوقات في جمع ماله
مخافة فقر فالذي يفعل الفقر!
وإن فتنة هذه الأمة هو في المال وعبادته كما في الصحيحين (فتنة أمتي في المال)، وقال (تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة)! فكم فتن المال من عالم وداعية، وكم ألهى من حركات وأحزاب، فدخلوا الأسواق لنصر الدعوة، فنصروا الأسواق وتركوا الدعوة!
وقد حذر الله نبيه من فتنة الدنيا وزينتها فقال له {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى}!
وإنما تتعطل الدعوات عن سيرها في طريق التغيير والإصلاح بالانشغال في المال وجمعه، والاستمتاع بفتنة الدنيا وزخرفها، وإنما يقود حركة التغيير المؤمنون المخلصون، وينصرها المعدمون المستضعفون، فهم أتباع الرسل وأنصارهم!
3- الجهاد في سبيل الله بمفهومه الشامل؛ ابتداء بجهاد النفس على الطاعة وفعل الخير وترك الشر، {من جاهد فإنما يجاهد لنفسه}، أو جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر {يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم}، أو جهاد الكلمة أمام أئمة الجور - كما في السنن الأربعة بإسناد صحيح -(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)، أو الجهاد بالأموال والأنفس لنصر دين الله وإعلاء كلمته في الأرض، وجهاد أعدائه {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}، فكل ما سبق من صور الجهاد تدخل في عموم قوله تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}
وقد وعد الله المؤمنين ووعده الحق وقوله الصدق أن ينصر من نصره منهم؛ فقال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}، وقال: {ولينصرن الله من ينصره}، وقال تعالى: {إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون}.
4-الأخوّة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار، التي تقوم على الحب والتعاطف والتراحم؛ كما قال تعالى: {هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم}، فالنصر كما تؤكد هذه الآية إنما تحقق بالمؤمنين بالأمرين معا كونهم مؤمنين، وكونهم متحابين متآلفين، وكما في صحيح مسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
فالأخوّة والمحبة هي سر النصر ومفتاحه، فإذا تحققتا بين المؤمنين والمصلحين الراشدين فقد انتصروا، إذ حاجة النفوس الكريمة الشريفة إلى المحبة أشد من حاجتها إلى ما سواها من حظوظ النفس وشهواتها، فهي تحيا بالحب، وتقاتل بالحب، وتموت بالحب؛ ولهذا كانت أشرف مراتب العبودية لله المحبة؛ كما قال تعالى: {فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم}، كما إن (أوثق عرى الإيمان الحب في الله) كما عند أحمد بإسناد حسن.
ولهذا أمر النبي ﷺ بإشاعة الحب - كما في صحيح مسلم - (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)، وكذا أمر النبي ﷺ بالتعبير عن مشاعر الحب تجاه الآخرين فقال – كما عند أبي داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم - (إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه)، لما في إشاعة الحب من تأليف القلوب، وتهذيب النفوس، وسعادة الأرواح، ولحاجة الجماعة لروح التضحية من أجل الدعوة التي تؤمن بها، ولا تتحقق التضحية إلا حين تتآلف القلوب، وتتحاب الأرواح قبل الأشباح، فيرى العضو سعادته في سعادة الجماعة، وحياته في حياتها، وفوزه في فوزها، فتبذل الأرواح والأموال رخيصة من أجلها، أخوة ومحبة ومودة وتضحية وإيثارا!
وليس المقصود بالأخوّة ما يتظاهر به المتظاهرون من ترابط وقلوبهم متنافرة، ومن تعانق وأرواحهم متباغضة، بل الأخوةّ خلة شريفة كريمة نبيلة أساسها الحب والود والإخلاص، وعنوانها الاحترام والتكريم والتوقير، وسقفها التضحية والإيثار والفداء!
5-الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين؛كما قال تعالى عن سبب إرسال رسوله محمد ﷺ: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} عامة، {ورحمة للذين آمنوا منكم} خاصة، وكذلك يجب أن يكون أتباعه رحمة للعالمين، وقد وصف القرآن أهل الإيمان بأخص صفاتهم وأشرفها؛ كما بشر بها في التوراة والإنجيل {رحماء بينهم}.
وقال ﷺ - كما عند أبي داود والترمذي وصححه - (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، وفي الصحيحين: (من لا يَرحم لا يُرحم)، وقال رجل: يا رسول الله إني أرحم الشاة أن أذبحها فقال له – كما عند الحاكم وصححه - (والشاة إن رحمتها رحمك الله)!
وقد أوصى الله بالأرحام التي يتراحم به العالمون؛ فقال: {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}، وجعل قطعها كالإفساد في الأرض {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم}، وقد أوصى النبي ﷺ – كما في صحيح مسلم - بأهل مصر خيرا، وعلل ذلك بقوله: (فإن لهم رحما)، أي: لكون هاجر أم إسماعيل جد العرب منهم؟
فدل على أن الأرحام مهما بعدت يجب تعظيمها؛ كما قال تعالى: {خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}.
ولهذا أمر القرآن بالإحسان إلى الخلق كافة {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}، {وقولوا للناس حسنا}، {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}، {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم}، {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم}.
وقال عن رحمة أهل الإيمان {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا}.
بل إن حسن الخلق وإكمال مكارمه من أسباب بعثته ﷺ – كما في الأدب للبخاري وأحمد وصححه الحاكم - (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، وإنما يتحقق حسن الخلق بهاتين الخلتين الرحمة والإحسان إلى بني الإنسان، على اختلاف أجناسهم وأديانهم، وقد جعل القرآن حقيقة الدين الإحسان إلى الخلق؛ كما قال تعالى: {أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين... ويمنعون الماعون}؛ فجعل حقيقة التكذيب بالدين، وبالحساب والجزاء يوم القيامة؛ طرد اليتيم، وحرمان المساكين، ومنع العون للمحتاجين؛ إذ لا يتصور أن تصدر هذه الأفعال ممن يؤمن بيوم الدين والجزاء، ويخشى الحساب والعقاب!
إن هذه الصفات والخلال - الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله، والاستقامة على دين الله، والأخوّة بين المؤمنين في الله، والرحمة والإحسان إلى الخلق لوجه الله - هي أهم ما يجب على المصلحين الراشدين التحلي بها، ومجاهدة النفس عليها؛ ليتأهلوا للاستخلاف في الأرض؛ كما وعدهم الله {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض}.
وليس المقصود مما ذكر في صفات القيادة والأعضاء أنه لا يقع منهم خطأ وقصور، أو ذنب أو فجور؛ بل كل ذلك يقع منهم، كما قال النبي ﷺ - عند الترمذي وأحمد بإسناد حسن - (كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)، وإنما الواجب توافر الحد الأدنى من هذه الصفات في الجميع والمجموع؛ لتحقيق الهدف ونجاح المشروع، فليس مشروع استعادة الخلافة الراشدة، وإقامة الحكومات الراشدة مشروعا سياسيا فقط؛ بل هو أيضا حركة إحياء روحية وأخلاقية واجتماعية وفكرية تعيد للإنسان المؤمن شهوده الحضاري من جديد، وتبعث الحياة في المجتمع الإسلامي من جديد، بعد أن فسدت التصورات والسلوكيات حتى بين كثير من دعاة الإصلاح؛ فانغمسوا في الدنيا، وركنوا للظالمين، وداهنوا المجرمين، وخالطوا المسرفين والمترفين، وعبدوا الدينار والدرهم، وافتتنوا فيها وفتنوا الآخرين، حتى يئس المسلمون من إصلاح الأحوال إذا كان هذا حال كثير من علمائهم ودعاتهم وحركاتهم الدينية!
ثالثا: شروط نجاح التنظيم الراشدي:
وإذا كان للقيادات الراشدة مواصفاتهم، وللأعضاء والأنصار صفاتهم، فإن للتنظيم شروطا ضرورية لنجاحه ومن أهم ما يجب مراعاته:
1- أن يعرف التنظيم الراشدي حق المعرفة ماذا يريد، وكيف يصل إلى ما يريد، فيعرف عقيدته السياسية بأدلتها الشرعية، ومشروعه السياسي، وما يحتاجه من زمن وجهد، وما يعترضه من عوائق، وما لديه من إمكانات، ويعرف أهدافه النهائية والمرحلية، والفرص القريبة والبعيدة، وكيف يتم تحضير المشهد السياسي لها.
2- وأن يعلم بأن مهمته هي من الأمة وبالأمة وإلى الأمة؛ فليس الهدف أن يصل التنظيم للسلطة، بل أن تصل الأمة إلى السلطة، وأن يتحقق الإصلاح الشامل، لتتحرر من كل عبودية، ولتسوس شئونها بنفسها، كما أراد الله لها، وإنما سيشاركها التنظيم في المضي معها نحو تحقيق هذا الهدف، ومن هنا يجب عليه أن يدرك بأنه سيكون جزءا من مشروع النهضة يتكامل مع كل القوى الإصلاحية التي تسعى إلى الإصلاح التعليمي والتربوي والأخلاقي والخيري والجهادي والسياسي؛ وهو ما يقتضي أن يكون التنظيم مفتوحا لكل من يريد الإصلاح، وقادرا على التعاون مع الجميع بلا استثناء.
3- وأن يكون التنظيم النموذج في إدارة شئونه بالشورى، وهو ما يقتضي أن يكون تنظيما أفقيا يتساوى فيه الجميع، وتتجلى فيه الشورى عند اتخاذ القرار، وتتحقق فيه قبل الحزم والعزم، الأخوة والمحبة، فلا أغلبية تفرض رأيها على أقلية، ولا كبير يفرض وجهة نظره على صغير؛ بل كما قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن - كما عند ابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح - (بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا)!
لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الرأي، فما يزالون يتحاورون حتى يتفقوا على رأي واحد، ويتطاوعوا عليه، ويترك بعضهم رأيه لبعض، ليخرج الرأي باتفاق منهم جميعا، ويلين بعضهم لبعض، كما في الحديث – عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح - (لينوا بأيدي إخوانكم، وسدوا الخلل).
لقد كان من أسباب نجاح الدعوة النبوية تحقق الأخوّة بين الجيل الأول بتعزيز أواصرها بالمحبة من جهة، وتحقق المساواة بينهم من جهة أخرى، حتى أن القادم إليهم لا يعرف من هو رسول الله ﷺ من بينهم؛ وكذا كان الخلفاء من بعده، فلا شارات، ولا ترتيبات، تميز بين أعضاء التنظيم، إلا ما كان من توقير وتقدير ورحمة - كما في حديث الترمذي وأحمد والطبراني بإسناد حسن - (ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا قدره)!
فلا يتحدث صغير في السن بحضور كبير إلا بإذنه؛ كما قال النبي ﷺ لمحيصة الأنصاري ومعه أخوه أكبر منه سنا –كما في الصحيحين - (كبّرْ كبّرْ) أي: اترك الحديث للأكبر منك سنا، ولا يتحدث غير مختص في العلم أو الفن بحضور المختصين والعلماء فيه.
4- وأن يتألف التنظيم الأمة على مشروعه، ويبث فيها دعاته، ويستقطب رجاله من أبطالها وأفذاذها وأذكيائها، ويستميل قلوبهم وعقولهم، وأن يسع دعاته الناس بأخلاقهم، كما – عند أبي يعلى بإسناد حسن - (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)، فلن تنجح دعوة اتخذت من الجدل سبيلا، ولا من الطعن في الآخرين دليلا؛ وإنما تنجح الدعوة حين تجعل المحبة حبلها الممدود بينها وبين الآخرين، وحين تتخذ من الدليل حجة لها على المخالفين، وحين تعرف الأمة منها صدق الدعوة، وإخلاص القصد، وأنها إنما تناضل من أجلها، وفي سبيل دينها وحريتها وكرامتها، لا للعلو في الأرض للوصول إلى السلطة، والفساد فيها، أو الاستئثار بها عليها!
5- وأن يكون الدعاة في التنظيم الراشدي في تغلغلهم في المجتمع وبين فئاته كالماء في ينزل من السماء، ويجري في الأرض، وينبع منها؛ فيصل لكل أرض، ويشرب منه كل ظمآن، لا يستطيع أن يوقفه أحد، ولا أن يحول بينه وبين الأمة أحد، فلا تصده السدود، ولا تحد من حركته الحدود، حتى يروي كل سهل وجبل، ثم يبارك الله نباته وزرعه حيث شاء الله ظهوره!
6- وعلى التنظيم في كل قطر أن يختار ما يناسبه من الأساليب، فقد يكون التنظيم الحزبي أو التنظيم الافتراضي أنسب لبلد دون بلد، وقد يكون العمل السري أفضل في وقت دون آخر، وقد عرفت الدعوة النبوية في مكة التنظيم الافتراضي، حيث لا رابط بين الأعضاء إلا إيمانهم بالدين، والأخوة فيما بينهم، فكان كل من يسلم يكون جزءا من الدعوة وأهلها، وربما أسلم الرجل فيخرج إلى قبيلته وبلده يدعو إلى الإسلام واتباع النبي ﷺ، فتنتشر الدعوة؛ دون أي ارتباط تنظيمي بين من كانوا يسلمون في كل مكان قبل أن يروا النبي ﷺ أو يبايعوه، كما عرفت الدعوة النبوية التنظيم الحزبي حيث البيعة ودار ابن الأرقم والجماعة، ثم لما بايع الأنصار النبي ﷺ اختار منهم اثني عشر نقيبا عليهم، يمثلون من وراءهم من قومهم من الأوس والخزرج؛ فالتنظيم الحزبي هم العصابة الذين قال النبي ﷺ عنهم يوم بدر (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا)، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: {رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون}، وقوله تعالى: {ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون}.
وقد فرّق القرآن في الأحكام بين المؤمنين المهاجرين والأنصار ومن يجاهد معهم في سبيل الإسلام، والمسلمين الذين لم يهاجروا ولم يجاهدوا، فليسوا سواء في الجهاد ولا في الإنفاق، فلم يكونوا سواء في الولاية وفي الاستحقاق {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى}!
كما دعا النبي ﷺ ثلاث سنين سرا حتى قويت الدعوة، واشتد عودها، وعرف المؤمنون فيها حقيقة رسالتهم ودعوتهم التي سيحملونها للعالمين، قبل أن يخرجوا للدعوة ومواجهة الجاهلية العالمية وطواغيتها!
7- وأن يدرك التنظيم في كل بلد أنه قد يتعرض لفتنة وشدة، وأنه قد يضيق عليه ويحارب، وقد يحال بينه وبين الوصول للأمة في مساجدها ومحافلها؛ وهو ما فرضه العدو المحتل على الأمة من خلال حكوماته التي أقامها منذ سيطرته على شئونها قبل قرن، إلا إن ذلك كله هو سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل مع كل دعوة للإصلاح والتغيير؛ كما قال تعالى: {أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}، بل إن الدعوات أحوج إلى الشدة لتمحيص صفوفها منها إلى الرخاء حيث يكثر الطامعون والمتسلقون والوصوليون {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب}!
وقد كان النبي ﷺ يثبت أصحابه بقصص الأولين وتضحياتهم وصبرهم؛ كما فعل حين جاءه الصحابة في مكة يشتكون شدة ما يلقون من العذاب – كما في الصحيحين - (لقد كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فينشر من مفرق رأسه حتى أخمص قدمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون)!
كما قد تتعرض الدعوة لفتن الترغيب أشد من فتن الترهيب، فتتعرض لفتنة المشاركة في السلطة والثروة على حساب أهدافها الرئيسة، كما عرضت قريش على النبي ﷺ أن يسودوه حتى لا يقطعوا أمرا دونه على أن يتركهم وشأنهم وظلمهم وطواغيتهم!
وقد سقطت كثير من الدعوات في هذه الفتنة حتى تخلت عن دينها ودعوتها وقضيتها؛ فصارت عونا للظالمين، بل ونصيرا للمحتلين، وظهيرا للمجرمين!
وقد حذر القرآن النبي ﷺ من أن يستخفه الذين لا يوقنون، أو يستفزه الذين لا يؤمنون، فقال تعالى: {فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون} وقال تعالى: {وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا... وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوا منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا}!
فثبات الدعوة على عقيدتها وقضيتها، وعدم استعجالها للوصول إلى أهدافها، على حساب مبادئها، وعدم سهولة استفزازها من قبل أعدائها لقطع الطريق عليها، كل ذلك من أهم أسباب قوتها ونصرها.
وربما ارتد عن الدعوة من يرتد، وقد يبيع بعضهم دينه بعرض من الدنيا قليل - كما في صحيح مسلم - (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا)، وقد ارتد عن الدعوة في مكة والمدينة وبعد وفاة النبي ﷺ أكثر ممن ثبت على الإيمان؛ فما زاد الإسلام إلا قوة، ولا زاد المؤمنين إلا عزيمة!
ولا يخش الدعاة إلى هذا المشروع الراشدي عدوهم وبأسه؛ فقد وعدهم الله بالنصر عليه؛ بل عليهم أن يخشوا من فساد ذات بينهم، وحظوظ نفوسهم، وتنافسهم على الدنيا وزخرفها، وقد حذر النبي ﷺ أمته –كما في الصحيحين - (والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم)!
8- كما على التنظيم الراشدي ألا يبخس المصلحين الآخرين حقهم، ولا يجحد سابقة جهادهم، وأن يتعاون معهم، فإن في الأمة طوائف لا تزال على الحق حتى في حال الاستضعاف والاغتراب وشيوع الجاهلية العالمية وهم :
أولا : المجاهدون في سبيل الله - كما في الصحيح - (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون - لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم - حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)!
ثانيا: المجددون لدين الله - كما في سنن أبي داود وصححه الحاكم - (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها)، ويدخل في ذلك كل من أسهم في تجديد الدين من العلماء المجددين، والدعاة المصلحين، أفرادا كانوا أو جماعات.
ثالثا: المصلحون - كما في صحيح مسلم - (إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء)، - وزاد الترمذي وحسنه - (الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي)، فيدخل في عمومهم كل مصلح سياسي، أو زعيم إصلاحي يعمل من أجل إصلاح حال الأمة وعودتها لقوتها وعزتها ودينها.
رابعا: العابدون والزاهدون والأبدال الصالحون وأهل الطاعة والخير الذين يذكرون الأمة بربها ودينها -كما في صحيح ابن حبان - (لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته).
فالواجب على التنظيم الراشدي أن يكون لهؤلاء جميعا ردءا وظهيرا، ومؤيدا لهم ونصيرا؛ كما قال تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا}، {وتعاونوا على البر والتقوى}.
9- أن يجعل التنظيم من مشروع: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) عقيدة ودينا ومنهجا ودعوة يؤمن بها كل عضو فيه، ويتثقف فيها، ويدعو إليها، ويحيا عليها، وأن توضع له المقررات والدورات لتدارس سيرة النبي ﷺ في إقامة الدولة، وسيرة خلفائه الراشدين، ودراسة سننهم في إقامة الخلافة، وباب سياسة الأمة، ومعرفة هديهم وسمتهم للاقتداء بهم، وتدارس أحكام الخلافة الشرعية، وتاريخ الخلافة ومراحلها، وما طرأ عليها من تراجعات، وما جرى لها من تطورات، وما أصاب الأمة بعد سقوطها، حتى يتحول مشروع نحو (أمة واحدة وخلافة راشدة) مشروعا للأحرار في الأمة كلها، تحشد له الطاقات، وتوظف له الخبرات، وتوقف عليه الأموال، وينضم له الرجال، حتى لا يمضي عقد أو عقدين من السنين إلا وقد قامت (حكومة أو حكومات راشدة)، تكون قاعدة لمشروع (الخلافة الراشدة).
10- أن يكون التنظيم على مستوى المسئولية التاريخية التي تصدى لها؛ فيجمع ولا يفرق، ويبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، وأن يحيط علما بالعصر وتطوره، وكيفية مواكبته، واستيعاب حضارته وتقدمه سياسيا واقتصاديا ومعرفيا، وأن يختار للقيادة أفذاذ الرجال، علما وخلقا وعزما وذكاء، وأن ينتقيهم كما ينتقى التمر، ويختبرهم كما يختبر الذهب، فإنما أوتي العمل الإسلامي من بعض قياداته، فسقطت وسقط معها مشروعها، وإن أشد ما في الإصلاح السياسي خطورة تداخل العامل الاجتماعي بالسياسي، فللمجتمعات ونظمها الاجتماعية قواعدها وأصولها التي تستعصي على من أراد تجاهلها، فليس كل فئة تستطيع قيادة المجتمع، أو يتقبل المجتمع قيادتها مهما اجتمع لها من الصفات، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وكما في الصحيح (تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)!
وأكرم معادن العرب آل البيت النبوي الشريف وبنو هاشم وقريش، ثم العرب على معادنهم ففي كل قبيلة معادنها من الذهب والفضة، وفي كل الأمم من غير العرب معادنها من الذهب والفضة، ولبعض الفئات من القبول ما ليس لغيرهم، وفي بعضهم من القوة والحمية والأنفة ما ليس في غيرهم، وربما وجد هذا التفاوت في القبيلة الواحدة، وفي الأسرة الواحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما فاضل الله بينهم في الأرزاق فاضل بينهم في الأخلاق والأعراق، فيجب مراعاة ذلك كله، فإن الإنسان يرجع إلى معدنه وطبعه، وربما ثبت الإنسان على موقفه مروءة وحفاظا على شرفه أكثر مما يقفه طاعة وحفاظا على دينه، فقد يجد في الدين رخصة عند الإكراه رحمة وتخفيفا وتيسيرا، ولا يجدها في قاموس الشرف وناموس المجد!
فنسأل الله الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.











الرسالة التاسعة (التنظيم الراشدي وشروط النصر)